لا تشبه لميس العراقيات، وكل ما فيها من حسن ورقة وخلق رهيف يشي بأن أصلها ليس عراقياً، بل مشرقياً شمالياً موغلاً في تواريخ شعوب أوراسيا. فهي طويلة القامة رشيقة القوام نحيلة الخصر، جسدها يكاد يخلو من التكورات المحببة لدى شعوب المنطقة. بيضاء البشرة لدرجة أن زرقة عروق ساعديها تشفّ أحياناً للرائي. عيناها عسليتان بصفرة تسللت إليهما من كهارب روسيا، ورموشهما طوال ملتفة حول الجفون، أما المقلتان فطويلتان مجرورتان كأنهما عيون جنيات البحر. فمها هو ذاك الذي وصفه الشعراء بأنه “مرسوم كالعنقود”، أما ضحكتها فربيع لا ينتهي.
رقيقة مثل زهرة، ونما فيها عبر سنوات الدرس حسّ فني مرهف، فدرست الفن وصادقت الفرشاة واللون، فتراكمت في غرفتها الصغيرة لوحات تحمل من اللون أكثر ما تحمل من لمسات القلم.
ولأنّها بالغة الرقة، فإنها أكثر عرضة للخدش بمرور نسمة، وهذا هاجس أمها وأبيها المقيم، رغم أنها كانت الوسطى بين بنيهم، لكنّ خشيتهم عليها تفوق خشيتهم على أختها الكبرى وأخيها الأصغر.
وكأنّ الأقدار تسوق لها مصيراً يناسب رقتها، فساقتها لتعمل في عالم تصميم الأقمشة بمكان يضجّ بالرشيقات الجميلات، فهو مركز لعروض الأزياء، وفيه تختلط الشعوب وتختلط الأهواء والميول، ويوحّد الجميع عنصر الجمال النادر. وهكذا كانت تمر بهدوء كل صباح في رواق الطابق الأول، لتصادفها العارضات الجميلات، وبعضهن ما كن يتقنّ حتى العربية رغم أنهنّ عراقيات!
وعرفت عن كثب هذا العالم الجميل الرشيق الملوّن، فالجميلات الرشيقات الرهيفات مجبرات على الالتزام بحمية قاسية للحفاظ على رشاقتهن، ومجبرات على التمرين في المركز الرياضي الخاص بالدار كل يوم، ومجبرات على السباحة لمدة ساعة في الحوض الداخلي للدار كل يوم، وهن ممنوعات من الحمل والولادة حتى بلوغ سن التقاعد! وهذا بحد ذاته كان شرطاً يتحدى طبيعة الأنثى لدى المرأة، فرفضن كثيرات مثلهن عروض العمل في الدار الأنيقة.
لميس كانت من بين أجملهن، لكنّ أهلها رفضوا بشدة أن تعمل معهن، فبقيت تعمل في قسم تصميم الأقمشة الذي كان يغذي السوق في تلك المرحلة بأنسجة ملونة مزيّنة بنقوش وخطوط، تنتجها لميس ورفيقاتها في القسم. وهذا البعد القريب عن عالم الجميلات طالما أثار في نفسها مشاعر الغيرة والغبطة تجاه عالمهن الأنيق. لكن، وبعد بضع سنوات، تعزز لدى لميس نفسها الأدراك بأن الدخول في عالم العارضات، يحمّلها خسائر كبرى، كان في طليعتها حرمانها من فرصة زيجة لائقة. وحين تقدم إليها ضابط في الحرس الجمهوري من النخبة القريبة لصدام حسين، ترددت في القبول لأنه اشترط عليها أن تترك عملها الجميل الملوّن، لكنّ أهلها وأصدقاء الأسرة ما برحوا يحثونها على قبول عرضه، حتى قبلته، فتغير مصيرها وابتعدت عن عالم الجميلات الحالم الغريب لتدخل إلى عالم التدريس الثانوي وعالم زوجات العسكر في زمن القادسية، أطول حروب القرن العشرين.
انتهت حرب السنوات الثمان، فخاضت لميس وزوجها منعطفاً جديداً، حيث سكنا في بيت أنيق باذخ مطل على دجلة في أغلى مناطق العاصمة، وكل ما في البيت فاخر ثمين عصري، كما امتلك زوجها سيارتين مطهمتين، خصص لها واحدة تتنقل بها من وإلى مدرستها الجديدة في العاصمة وإلى بيت أهلها وإلى مصالحها الأخرى، فيما بقيت الثانية أغلب الوقت واقفة في باحة البيت لا يستعملها المقدم الأنيق لأنّ سيارات المعسكرات كانت دائما في خدمته، وكلها حديثة أنيقة.
ومع غزو الكويت، اهتزت حياتها بشدة، إذ كان زوجها ضمن القطعات التي غزت الكويت، ثم أباد طيران قوات التحالف الدولي وحدته، لكنّه نجا بأعجوبة وعاد إليها ليعيشا معاً سنوات الحصار الصعبة، التي لم تكن عليهما سنوات صعبة، بل أقل رفاهية.
تسعُ سنوات مرت على تلك الزيجة، لكنّ أحد أهم أركان الأسرة بقي غائباً، إذ لم ترزق لميس بطفل يتوّج اسم العائلة ليكون امتداداً لهما. وحاولت مع كل وسائل وامكانات الطب الحديثة، إلا أنّ عيباً مجهولاً ما برح يحيل دون اكتمال سعادتها، وبقيت قلقة مؤرقة قابلة لقدرها التعيس.
منتصف التسعينات، تكشفت لها مصيبة كانت خافية عنها لبضع سنوات، فزوجها الكولونيل قد تزوج سراً من امرأة أخرى وقد انجبت له ولدأً وبنتاً، وهي تسكن في بيت مستقل قريب على بيت أهله في مدينة صغيرة نائية غرب العراق. المصيبة المدمرة انكشفت حين انفصلت الزوجة الجديدة عن الكولونيل وباتت تطالب بالطلاق، فاتصلت بلميس شخصياً والتقتها وروت لها كل القصة. وكانت تلك ضربة قاصمة لعالم لميس المرتب الباذخ الجميل، فهي ليس الوحيدة في حياة الكولونيل، والأقسى من ذلك أنّ الزوجة الجديدة تتفوق عليها بثمرتين، هما امتداد الأسرة الذي طالما بحث عنه زوجها.
تلك العاصفة، أطاحت بعلاقتها بزوجها بشدة، فانفصلت عنه، وعادت إلى بيت أهلها، واستمرت القطيعة عاماً كاملاً حتى حصلت الزوجة الثانية على الطلاق من زوجها وتركت له الولد والبنت، فعاد الكولونيل يعرض على لميس عرضاً سخياً آخر، اذ بات بوسعهما أن يعودا لبعضهما لو قبلت لميس أن تكون أمّاً للصغيرين. وهكذا كان، فبعد بضع أشهر عادا ليعيشا في بيت جديد أنيق، ومعهما هذه المرة طفلان جميلان يناديانها بماما لميس!
حملت هذا اللقب بفخر، وغمرت الطفلين بحنانها وعشقها فنسيا أنّ لهما أماً، ولم يعرفا في العالم سوى ماما لميس، لاسيما أنّ الأب بحكم وظيفته كان يغيب عن البيت فترات طويلة.
وبات الكولونيل جنرالاً، وصارت لميس زوجة الجنرال المدللة، ودخلت معه عالم الأقوياء فخورة بجمالها الخارق وبطفلين جميلين مدللين يعلنان انتصارها المطلق في ميدان الأنوثة، انتصار حاسم رغم نكهة المرارة التي تلازمه.
وعرفت عن كثب زوجات الكبار، فخالطتهن وأمست تربطها بهن مصالح وزيارات وصداقات، ولم يعد من الصعب عليها أن تعيش تلكم السنوات العجاف التي عاشها العراقيون. ثم اشترى لها الجنرال بيتاً ليكون هدية عيد زواجهما السابع عشر، كان بيتاً كبيراً حديثاً، آثرت أن تُسكن فيه مستأجرا، كي يدرّ عليها دخلاً ثابتاً كل شهر بعد أن استقالت من وظيفة التدريس وتفرغت لرعاية الأطفال.
ثم جاء زلزال 2003، فانقلبت الأوضاع في أرض الرافدين، وصار زوجها طريداً يبحث عنه الأمريكان واجهزة أمن السلطة الجديدة، حتى اعتقلوه وزجوا به في سجن مرعب.
عادت لميس ومعها ابنتها وابنها ليعيشوا في بيت أهلها، فيما أمضى الجنرال 3 سنوات عجاف في السجن، خرج بعدها ناحلاً وقد اهتز عالمه الذي اعتاد عليه، وفقد إلى الأبد القوة الكاسحة التي كانت في يده، ومعها فقد حضوره الاجتماعي، اذ بات يتخفى عن الأعين خشية فوهات الكاتم التي باتت تستهدف جنرالات الحقبة السابقة. وهرب أخيرا إلى إمارة خليجية غنية، ليعيش هناك حياة جديدة، وما إن استقر حتى التحقت به لميس وابنيها لتبدأ العائلة الصغرة حياة جديدة.
استعاد الجنرال حظوته لدى سلطات الإمارة، ووصلته أموال من بيع أملاكه في العراق، كما خصص له راتب تقاعدي كبير يصله من بلده كل ثلاثة أشهر، فتحسّن وضعه واشترى شقة أنيقة تطل على مياه الخليج، فيما انخرط ابنه وابنته في مدارس الخليج، وعادت لميس لتعمل براتبٍ محترم مدرسة لمادة التربية الفنية في إحدى مدارس البنات في الامارة.
الصفحة الجديدة في حياة لميس أعادتها إلى عالم القوة بالقرب من عالم الأميرات والشيخات الخليجيات المنعمات بحياة البترودولار الباذخة.
لميس الجميلة من اوراسيا تنعم اليوم بحياة هانئة وبات ابنها وابنتها نجوماً في مجتمع إمارة النفط المترفة.
ملهم الملائكة / قصة من مجموعة “خرائط العراقيين الغريبة”






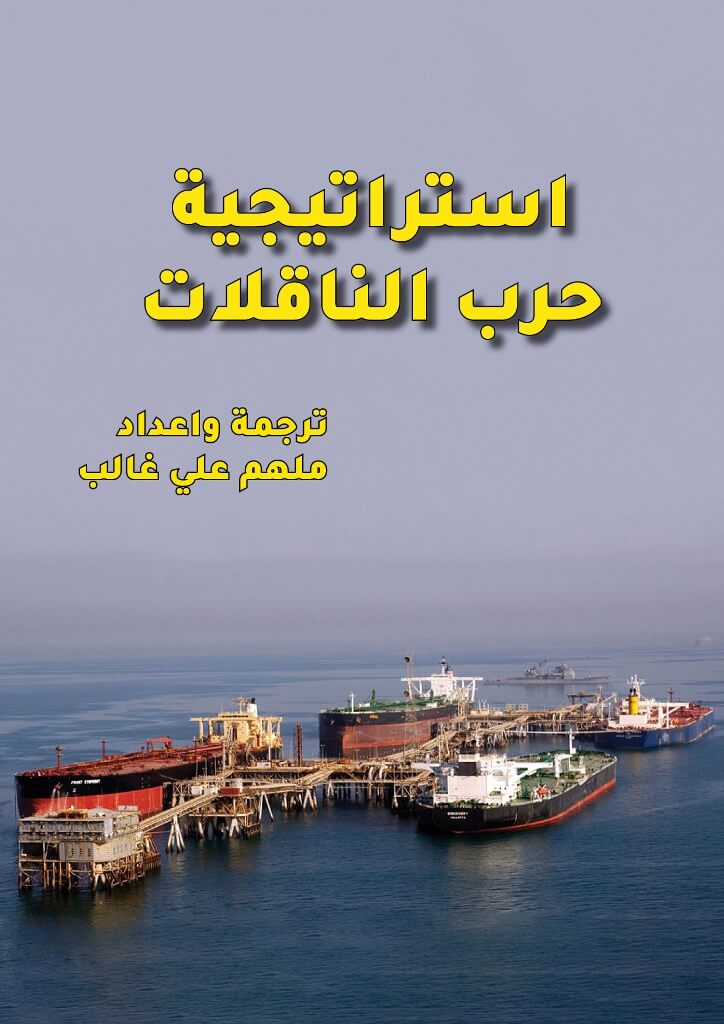
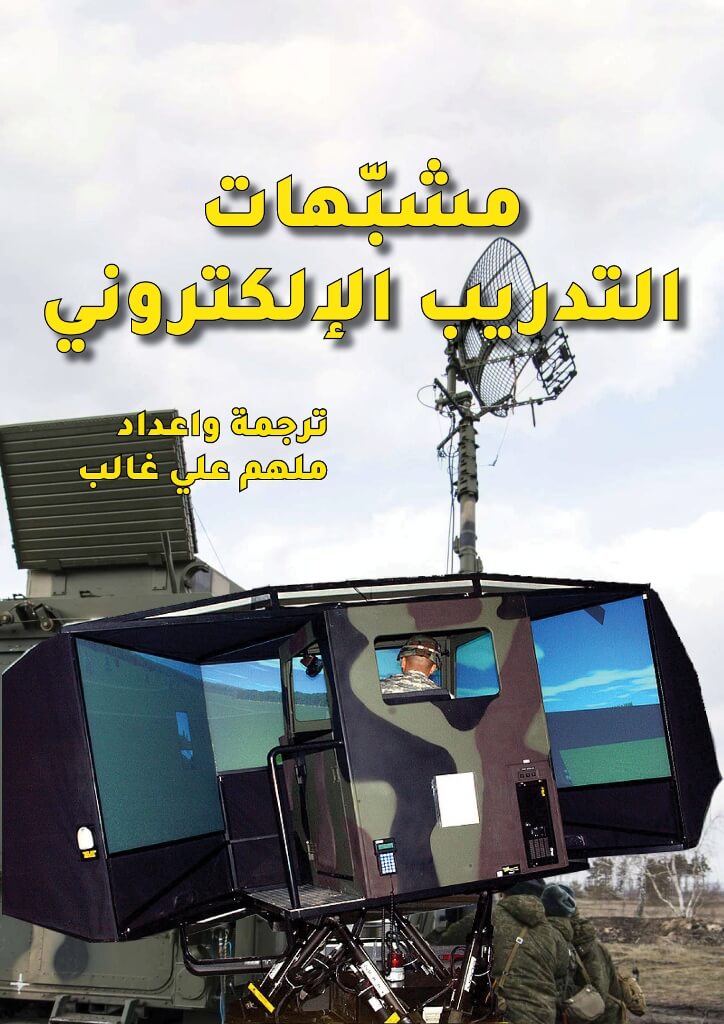
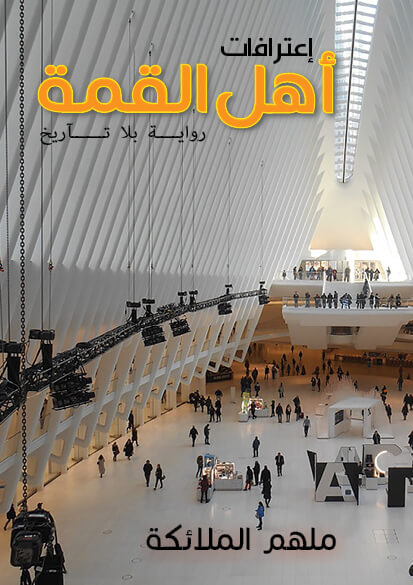




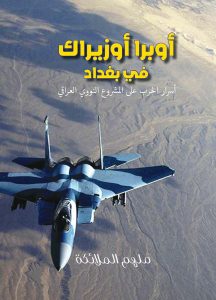
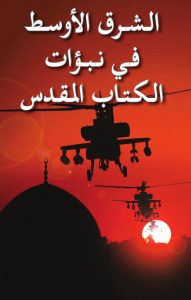








0 تعليق