الثابت حسب بعض المصادر أنّ أول رجل في الإسلام لقّب بالصوفي هو (أبو هاشم الكوفي)، المولود بالكوفة أيام كانت عاصمة للدولة الإسلامية في عصر الراشدين، هذا هو رأي عبد الباقي غول بنارلي، لكن الباحثين العرب القدامى، مهما أجهدوا أنفسهم لإرجاع لفظة (الصوفي) إلى أصول عربية، فإنّ جهدهم يظل متّصفاً بطابع التكلّف والتمحّل، ذلك أن أية مراجعة للغة الإغريقية كفيلة بأن توضح الأصل الحقيقي لهذه اللفظة، ففي الإغريقية توجد لفظة Sofos وتعني الحكيم، ومنها أخذ العرب لفظة فيلسوف، كما أخذوا لفظة (سفسطائي) وتعني المغالط والفيلسوف أيضاً، وكذلك فعلت اللغات الأوروبية جميعاً، ففي الإنجليزية توجد كلمة Sophist وتعني المعلم السفسطائي والمغالط، ولفظة Sophistry وتعني السفسطة أو المغالطة، والألفاظ ذاتها تتكرر في جميع اللغات الأوروبية أيضاً، لأنها مشتقة من ذات المنبع.
من ناحية أخرى، فإن أيّة دراسة للتصوف، يمكنها أن تؤكد الصلة الوثيقة بين المتصوفة المسلمين، والسفسطائيين اليونان! فالصوفي، مثل السفسطائي، لا ينفك يطوف البلدان لتعليم الحكمة وبث المبادئ الأخلاقية، وكلاهما يستخدم من أجل تحقيق هذه الأهداف سبيل الإقناع والتأثير، عن طريق المُناظرة والحوار حيناً، والخطبة والتدريس حيناً آخر. ومن مهمات الرجلين: تنمية سُبُل الوعي والفهم والمحاكمات العقلية المنطقية، وتدريب الناس على النقد، وعدم القبول بمظاهر الأشياء، والبحث عن الخفايا التي لا تبدو على السطح، كل هذه الاهتمامات تتجاوز رداء الصوف أو المسوغ الخشن الذي أصرّ بعض اللغويين العرب على نسبة (المتصوف) إليه. ومع ذلك، فإن علماء اللغة العرب ترددوا في هذه النسبة، فجار الله الزمخشري في (أساس البلاغة) يقول في باب (ص وف) (إن آل صوفان كانوا يخدمون الكعبة ويتنسّكون، ولعل الصوفية نُسبوا إليهم تشبهاً بهم في النسك والتعبد، أو لعلهم نُسبوا إلى الصوف وهو لباس أهل الصوامع)، ألا تثير هذه الملاحظة شكاً كبيراً في أن آل صوفان هؤلاء نسبوا أنفسهم أيضاً إلى السفسطائية؟ ونحن نعلم أن (الأصنام) التي كانت تُعبد عند العرب، إنما تُصنع في بلدان الروم على الأغلب، ومن يخدم الأصنام، لا بد أن يكون ذا صلة بكبار صانعي الأصنام أو (التماثيل) في تلك العصور، وهم اليونان والروم القريبون من العرب، لأنهم يحكمون بلاد العرب يومئذٍ (أعني قبل الإسلام).

والواقع، أن العرب لا تنسب إلى أصناف الأقمشة إلا في حالة التجارة والبيع وما أشبه، فتقول: رجل حريري؛ أي يبيع الحرير، أو إذا أرادت أن تُبيّن جنس القماش، فتقول: قطني أو صوفي أو كتاني.. الخ. ولا أحد يصف الرجل الذي يفضل ارتداء الملابس القطنية مثلاً بأنه قطني، أو أنه كتاني، أو صوفي! ولماذا كل هذا التكلُّف والتصنُّع واللفظة حاضرة بكل مشتقاتها واستعمالاتها المُنوّعة في اللغة الإغريقية التي أخذ عنها العرب في عصور حضارتهم عشرات الألفاظ والمصطلحات دونما أي شعور بالحرج، كما يفعل جميع البشر اليوم، حين يأخذون المصطلحات الشهيرة دون أي تحرّج، فمن الفضول أن نُطالب الإنسان العادي في أي مكان أن يترك كلمة (تلفون) ليقول: هاتف، أو كلمة (راديو) ليقول مذياع، وأمثال هذه الألفاظ التي تستعملها البشرية على نطاق العالم كله. التعريب لا يعني هذا مطلقاً. فحتى القرآن الكريم استعمل عشرات الكلمات غير العربية، ومن يقرأ أدبنا العربي القديم وتاريخنا الإسلامي، فسوف يجد آلاف الألفاظ الأعجمية المُستعملة عالمياً يومئذٍ، موجودةً على حالها، أو مُحرّفةً قليلاً. فالعرب استعملت لفظة (اصطرلاب) ولفظة (بستان) و (بنفسج) و(بيمارستان) و(جوسق) و(جوهر) و(الجوظ) و(الجورب) و(الجاموس) و(الجوشن) و(ديباج) و(ديوان) و(دكان) و(درهم) و(دورق) و(دانق) و(دمقس) و(دست) و(دهقان) و(الدرفس) و(رستاق) و(زنبق) و(زاج) و(زنجبيل) و(سجبخل) و(سلحفاة) و(سرداب) و(شطرنج) و(شاهين) و(طومار) و(طاق) و(طنبور) و(طلسم) و(فسطاط) و(فالوذق) و(فهرست) و(فذلكة) و(قهرمان) و(قمقم) و(قانون) و(كيمياء) و(كافور) و(لاهوت) و(هزار) و(هيكل) و(ياسمين)، ومئات بل آلاف أخرى من الألفاظ الأعجمية ببساطة طرحت للنقاش على مستوى العالم العربي كله، والمجامع العلمية وحدها تعجز حالياً عن إيجاد الحلول الفعّالة المؤثرة، كما عجزت في الماضي، رغم المنافع العظمى لهذه المجاميع، ورغم الجهود المُضنية التي يبذلها أعضاؤها الأفاضل، من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة.
من ناحيةٍ أخرى، فإن الصوف لم يكن دوماً قماشاً للمسوح الذي يرتديه الصوفي!! وكثير من المتصوّفة يُميّزون أنفسهم بالقلنسوة التي يضعونها فوق رؤوسهم، بشكلها أو بلونها. والملامتية رفضوا أن يُميّزوا أنفسهم من الناس، بأي مظهرٍ خارجي، وهناك طائفة (القِزِل باش لي) أي ذوي الرؤوس الحمر، وهم فئة صوفية ميّزوا أنفسهم بغطاء الرأس الأحمر اللون، وانتشروا في الأناضول، أما جلال الدين الرومي نفسه، فإنه لم يتقيّد بأي ملبسٍ خاص، لكنه حين تعرّف بشمس راح يضع القلنسوة فوق رأسه مثل صاحبه.
يُميّز الصوفي المعروف عبد الرحمن السلمي (ت412هـ) بين المتصوفة والشطار؛ فالصوفي لا بد له أن ينتسب إلى شيخ يُرشده إلى الطريق، ولا بدّ له من لباسٍ خاص، واحتفالاتٍ ذات طقوسٍ محددة، يكرّرون فيها أسماء الله “الذكر”، ولا بدّ لهم من تكايا أو خانقاهات يجتمعون فيها، ويتدرّبون على السلوك تحت إشراف شيوخهم ..الخ.
أما الشطّار، فلا صلة لهم بهذا كله! وليس هناك شيء مظهري أو سلوكي يُميّزهم عن غيرهم من البشر، وإنّما هم أشخاص انطلقوا من مفاهيم عاطفية وجدانية فحسب، إذ لا همّ لهم غير الاستغراق في العشق والوُجد والارتقاء في هذه المراتب، من أجل الوصول إلى حالة الاتحاد بحسب طرقهم ومصطلحاتهم.
تشكّلت النقابات “الأصناف” في المجتمع الإسلامي أثناء القرن الثاني للهجرة، وطغت عليها صبغة صوفية واضحة، وأُطلِق على أعضائها اسم الفتيان، أو (الآهي لر) فيما بعد عند الأتراك، وضمن هؤلاء، نجد مختلف الصُنّاع والحرفيين والفنانين، وهلم جرا. هذه الطبقة من أهل الحرف، كانت مرتبطة بوشائج بعيدة تعود إلى العهد الساساني في إيران، فلا عجب أن تظهر في مؤسسات الفتوة الإسلامية معتقدات فارسية عتيقة، كان من أهمها مذهب الملامة. إن الملامتية فئة تتظاهر بتحقير نفسها، وأعضاؤها لا ينفكّون يُوبّخون أنفسهم ويلومونها، ويعمدون إلى اقتراف أعمالٍ مُثيرةٍ للاستنكار والاشمئزاز، مما يعود بالذاكرة إلى مسالك بعض طوائف البوذية من جهة، ومفاهيم المذهب الكلبي Cynicism من جهةٍ أخرى.
لكنّ أهل الملامة والفتوة خالفوا المتصوفة، في أنهم لم ينسحبوا من الدنيا، بل على الضد من ذلك، ارتبطوا بالمجتمع أشدّ ارتباط، وفي القرن السادس الهجري (12 ميلادي) تغلغلت في نظامهم عناصر باطنية، وانقسموا إلى فئاتٍ وطوائف مُتباينة مختلفة، فكان منهم الدراويش القلندرية، والبكتاشيون نسبةً إلى الحاج (بكتاش ولي)، وطائفة الحيدرية، الذين ألّف بينهم الشاعر فريد الدين العطّار رسالته المُسمّاة (حيدري تامة)، وهناك الشيوخ الأبدال الذين ظهروا كدراويش مُتجوّلين منذ القرن السابع للهجرة، الخ.
في مورد متصل، أدى ارتفاع شأن التصوّف منذ القرن السادس الهجري إلى امتزاج المتصوّفة بطبقة الصفوة وأهل السلطان والنفوذ في المجتمع، وتهيّأ للصوفية التنعّم بضروب الترف والرفاه، بعد أن تناثرت الأموال والهدايا عليهم من كل جانب، وصار لهم في الأوقاف حصص كبيرة، فتهيّأ لشعائرهم وطقوسهم الازدهار والانتشار بين مختلف طبقات الشعب، لا سيما الرقص والموسيقى. وبهذا، أصبح المتصوفة أشبه بطائفةٍ مستقلةٍ منفصلة عن المجموعة، وشرعوا ينظرون إلى عامة الناس نظرة ترفُّع وازدراء، مُستندين إلى أفكار الإسمعيلية الشائعة يومئذٍ، وأطلقوا على الكُتل الشعبية الضخمة ألقاب التحقير، مثل: الطغام، والعميان، وأهل الغفلة والجهالة، بل وصل الأمر بهم إلى تلقيب العامة بالحمير والبقر، في حين لقّب المتصوفة أنفسهم بالعارفين وأهل الله وشيوخ الطريقة الإلهية، الخ.
غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، ذلك أن الفئات الانتهازية وجدت في التصوّف فرصةً نادرةً تخفي بواسطتها أغراضها ومطامعها، فارتدى زي التصوف كثير من طُلاّب المال والنفوذ، وأصحاب المطامع الضيّقة، وأهل الشذوذ الخُلُقي، واللصوص، والشحاذين، والمجاذيب، وحُثالات المجتمع، مما أساء إلى الحركة الصوفية، وساهم في زيادة التصدّعات والانشقاقات بين أجنحتها.
إحسان الملائكة
*فصل من كتاب جلال الدين الرومي صائغ النفوس






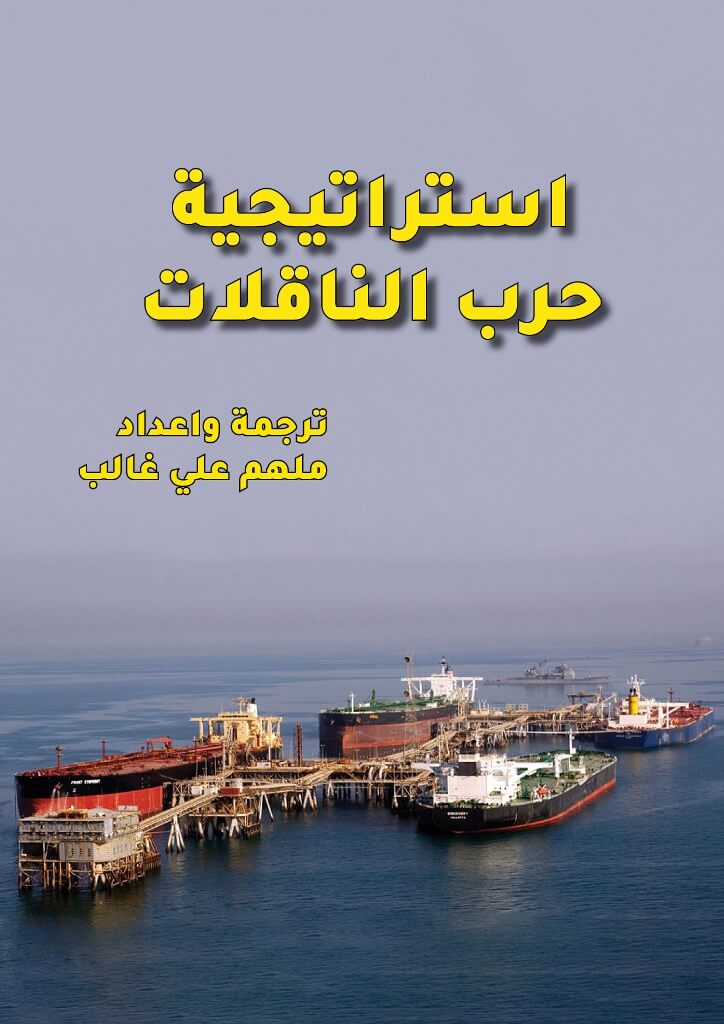
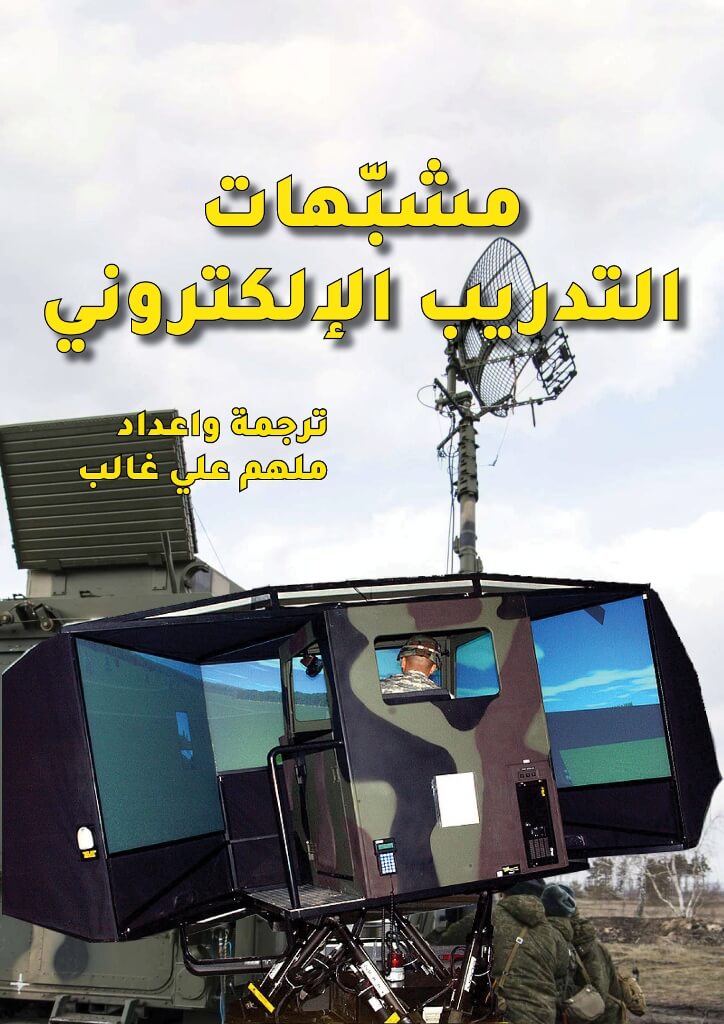
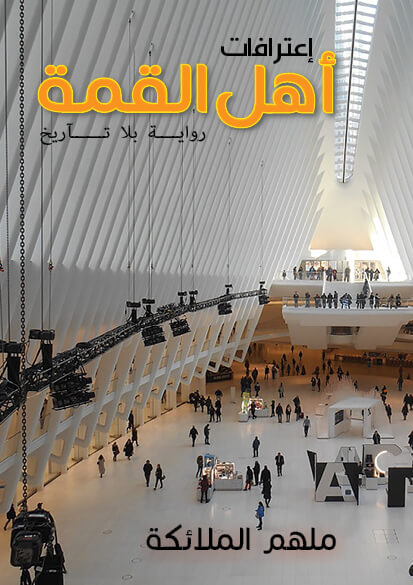




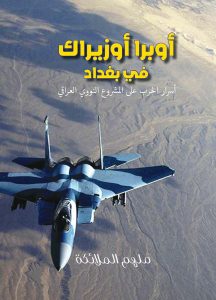
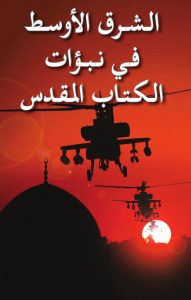








0 تعليق