يتحدث نواب العراق بملء افواههم عن تشريع قانون الخدمة الإلزامية، في محاولة لإعادة نظام السخرة العسكرية الى الحياة، حيث يفتح مزاد الحرب بجنود يشترون الخدمة ويدفعون بدلاً نقديا، فيما يمشي ألوف الجنود إلى الحرب وهم ينشدون للوطن الخربان والقائد الضرورة!
حكام الأمم الفقيرة يريدون الحروب ليشغلوا شعوبهم الجائعة بمهنة الموت، وليكمّموا الأفواه بحجة قوانين الحرب والطوارئ و”الأمن القومي والوطني”، وهناك دائما من يقبل أن يشاركهم الحرب بمرتبة “عدو” ليشغل هو الآخر شعبه الفقير أو الذي يريد أن يفقره ويجوّعه ليضمن تبعيته.
حين تضع الحربُ أوزارها (تبدأ)، يفرحُ الضباط فهي موسم حصاد الأمجاد والأوسمة والجوائز والمكافآت، وحين تَرفعُ الحرب أوزارَها (تنتهي)، يفرحُ الجنودُ لأنّهم ما زالوا أحياء. الفرق شاسع بين الفرحتين.
في زمن الحرب لا يبقى أمام الفقراء سوى الجندية، وتتفاوت الأجور حسب الأمم وفقرها وحسب مموّلي الحروب، لكنّ الأجر دائما لا يتجاوز ما يسد الرمق، وسمعت دائما وصف هذا من خنادق حروب العراق حيث كنت أسأل الجنود ما تأكلون؟ فيقولون “الحمد لله خير، المهم السلامة”، ولسان حالهم “قوت لا تموت”.
جندية الفقراء غير جندية الأغنياء، ففي أغلب دول العالم المتحضر والدول الغنية أُلغيت الخدمة العسكرية الإلزامية التعسفية، وباتت خدمة الدفاع عن الوطن مهنة تطوعية يدخلها المرء بعقد، ليكون جنديا لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس وتجدد وتمدد حسب تجديد العقد، ولا مجال لأن تنقض الدولة الاتفاق وتجبر الجندي على البقاء في الخدمة إلى ما لا نهاية، كما هو الحال في الدول الفقيرة والمتخلفة والتي تحكمها أنظمة دكتاتورية، وقد كان جنود العراق وسوريا ومصر والسودان المتطوعون يوقعون عقودا مع الحكومة لمدة خمس سنوات، لكنهم يلبثون في الخدمة حتى يموتوا أو يتقاعدوا بأجر زهيد لا يليق بإنسان.
حين تجادل المسؤولين عن ترشيد القوى البشرية وتشغيلها في وزارات تخطيط بلدان فقيرة متخلفة أو تحكمها أنظمة دكتاتورية، يجيبونك بحجة مقنعة، فكيف تشغّل عاملا لا يعرف الكتابة والقراءة ولا يتقن سوى استخدام المعول والمطرقة والمجرفة والمنجل؟ لا عمل له إذا سوى القتال والقتل، وهذا يتطلب حرباً، فلتقم الحروب لأنّها خير مؤسسات للعمل في هذا العالم. كم أجر هذا الجندي الأمي غير الماهر الذي لا يتقن استخدام وسائل القتال الحديثة؟ إنّه أدنى أجر طبعا، ولا أريد التسميات إلا أنّ جنود أغلب دول العالم العاملة بنظام الخدمة الإلزامية سيء الصيت لا تتجاوز رواتبهم الشهرية في أحسن الظروف الآن ونحن في الألفية الثالثة (20 دولارا في الشهر).
أمام الجندي الأمي الفقير حلان، إما المشاركة في الخدمة الإلزامية للدفاع عن الوطن في محنته التي صنعها القائد الرمز، فيموت وأجره 20 دولارا في الشهر، وإما أن يتخلف عن تلك الخدمة، فيُحسب في صفِّ أعداء النظام الحاكم، وعليه أن يهرب خارج حدود سلطة القائد، فيكون مع المعارضة ومع أعداء النظام، وتسوء أحوله وأحوال أهله، كما أنّ لديه خيارا آخر هو أن يبقى هاربا عن “خدمة العلم” متخفيا، فتطارده وتصطاده قوات التعقيبات وترسله إلى ساحات الإعدام ليموت مجانا بتهمة التخلف عن حماية الوطن، وعلى أهله وذويه غالبا أن يدفعوا ثمن الرصاصات التي وضعت حدا لحياته.
أمّا الضباط، فوظيفتهم شيء آخر، إذ ينالون رواتب تتفوق على رواتب موظفي الدولة، وتشملهم قوانين استثنائية، فتخصص لهم قطع أراضٍ سكنية مجانا أو بأثمان رمزية، وتباع لهم سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، ويمنحون تسهيلات زواج وعلاج لهم ولعائلاتهم، ما يجعلهم في كل مجتمع طبقة مرفهة تنتمي الى النخبة، وهذا ليس مجانا، فوظيفة الضابط قيادة الجندي في المعركة.
وليس مؤكدا تماما أنّ الضباط يتفوقون على الجنود في فنون القتال، فغالبا وجدت الجنود يتقنون التعامل مع السلاح ومع العتاد والتجهيزات الشديدة البسيطة أكثر من الضباط، كما أن شدة ظروف القتال تجعل الجنود أكثر خشونة وقدرة على التحمل من ضباطهم وأكثر معرفة بتقلبات ميادين القتال وأحوالها، بل وأكثر معرفة بنوايا العدو الظاهرة للعيان في خطوط التماس وليس بنواياه وخططه العليا.

لماذا يقال إذا إن الحروب يقودها الضباط ليموت فيها الجنود؟
الحرب تعني أن يذهب الجندي إلى موت محتمل طائعا مختارا، فمن يفعل هذا لأجل 20 دولارا في الشهر؟
هنا دور الضابط، إنّه يقود الجندي الى معركة يُحتمل بشدة أن يموت فيها، هو يُجبره أن يخاطر بحياته دفاعا عن القائد، فالضابط إذا حارس القيم التي يبثها القائد، ومنفذ خطة الزعيم الأعلى الذي يشن الحرب. الضابط لا يُقاتل، ومن نراهم يحملون البنادق والرشاشات والرمانات من الضباط هم صناعة سينمائية إعلامية ليس أكثر، فالضابط صانع معنويات، يحضر مع جنديه في الخط الأول ليقنعه بموت محتمل أو بنصر يجني ثماره القائد وتنال الضابط الآمر حصة من تلك الثمار، أما الجندي الذي لا يموت فيُلقى به إلى الرصيف إذا انتهت الحرب ليعود إلى مهنة البطالة عن العمل.
قد يموت الضابط وهو يضخ المعنويات والعزيمة في أرواح الجنود في خطوط القتال المتقدمة، لكنّ موته جزء من عقده مع الحكومة والقيادة، الموت دفاعا عن القائد، وهو احتمال يتضاءل كلما ارتفعت رتبة الضابط وزاد عدد الجنود الذين يقودهم. وهذه نماذج لاحتمالات موت الضباط نسبة إلى جنودهم:
*ملازم، ملازم أول، يقود فصيلا يضم من 33 إلى 40 جنديا، احتمالات موته إذا واحد إلى أربعين.
* نقيب، رائد، يقود سرية تضم من 90 إلى 120 جنديا وضابطا، احتمالات موته إذا واحد إلى مئة وعشرين.
*مقدم، عقيد، يقود فوجا/ كتيبة يضم من 400 إلى 800 جندي وضابط، احتمالات موته إذا واحد إلى ثمانمئة.
*عميد، لواء، يقود لواء يضم من 2600 إلى 3000 جندي وضابط، احتمالات موته إذا واحد إلى ثلاثة آلاف.
* فريق، فريق أول، يقود فرقة تضم من 8 آلاف إلى 10 آلاف جندي وضابط، احتمالات موته واحد إلى عشرة آلاف.
وهكذا تتدرج الرتب وتتناقص احتمالات الموت ميدانيا. إنّه ليس غُبنا، بل صناعة اعتمدتها الجيوش والأنظمة عبر التاريخ.
ونهاية حرب استمرت عقدا كاملا ستجعل الضابط يخرج منها بثلاث إلى خمس نجومٍ إذا كُرم، مع بيت وبستان وأكثر من سيارة ومكافآت عدة. أما بالنسبة للجندي فإنّ مكافأته أن يخرج من المحرقة سالما وفيها الغنيمة، وعليه أن يرجع إلى الرصيف أو الحقل الأجرد العطشان الذي غادره إلى ساحة الحرب ليبدأ من الصفر وعمره قد جاوز سن الشباب.
ملهم الملائكة
*نشر في صحيفة العرب اللندنية في مثل هذا اليوم قبل 4 أعوام!






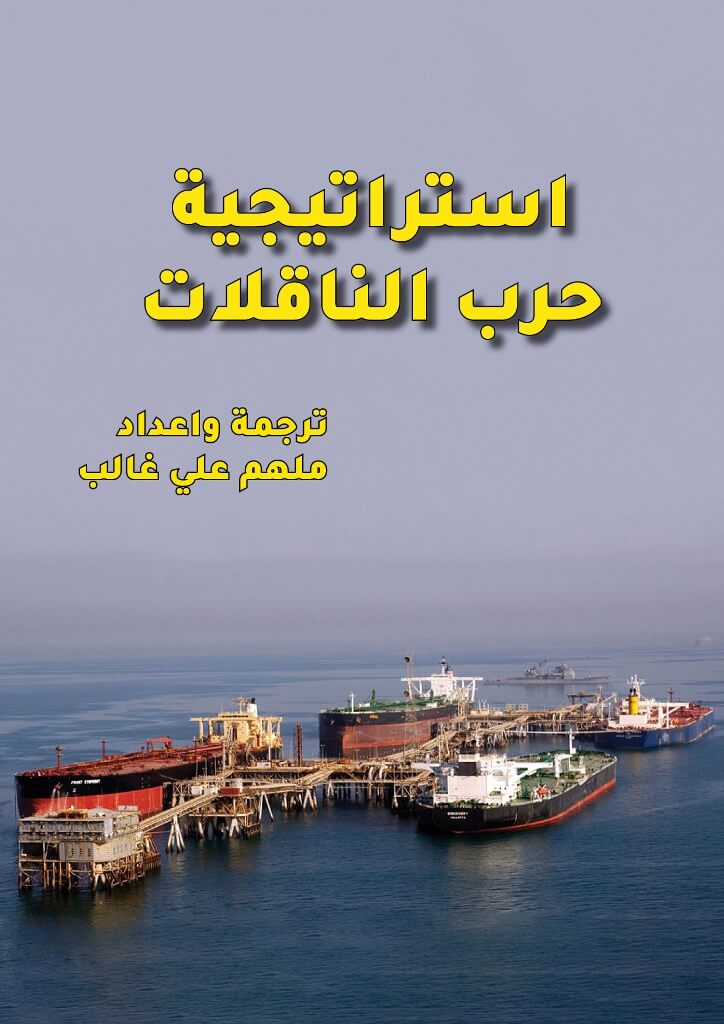
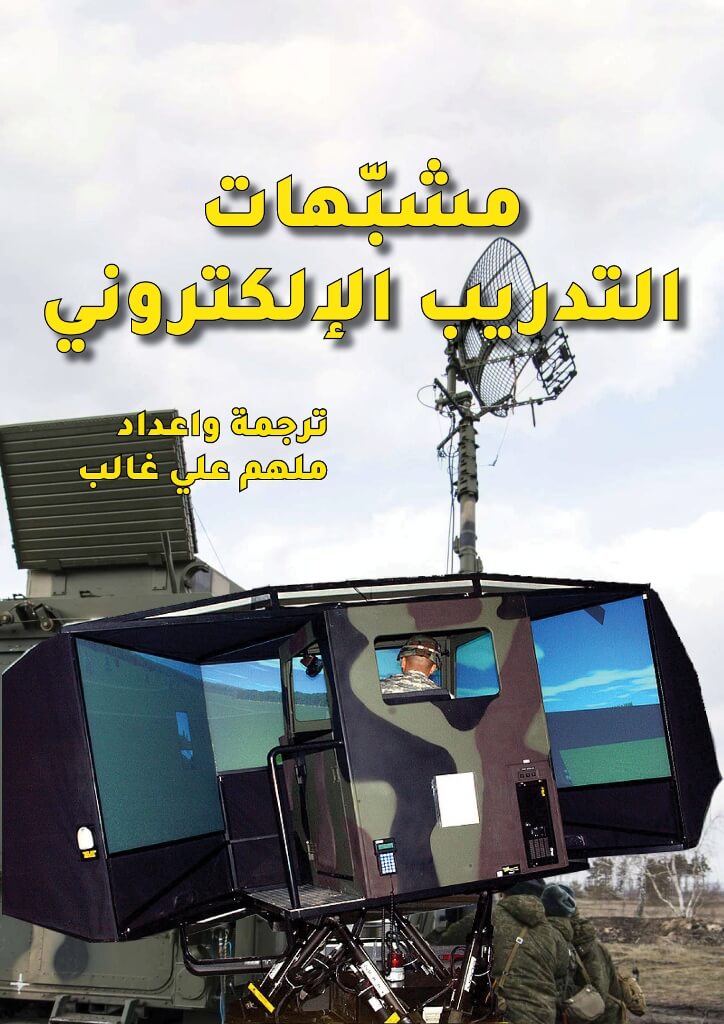
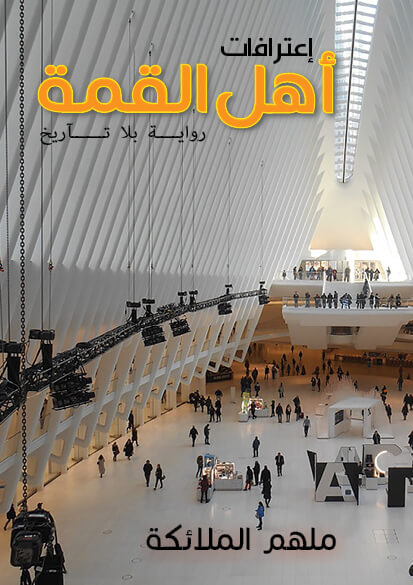




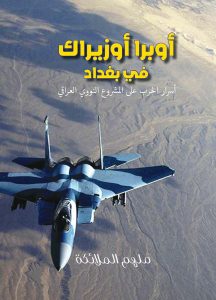
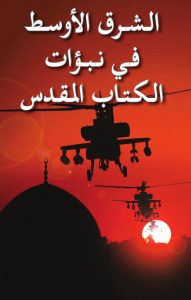








0 تعليق