واذهب فقيرا كالصلاة
وحافياً كالنهر في درب الحصى
ومؤجّلاً كقرنفلة – محمود درويش
لا يدري إن كان حقاً ينتمي إلى هذا الوطن أم لغيره، فقد تعددت قراءات زمنه حتى ما عاد يهتم إن كان الأمر حقيقة أم كابوساً طويلاً امتد لثلاثة وعشرين عاماً منذ أن جاءوا به من مخبز سيد خضر في الكاظمية. وكم حاول أن يقنعهم أن الموضوع هو محض سوء تفاهم أوقعه فيه أبوه مذ كان في الثامنة عشرة حين شاء أن يخلّصه من الخدمة العسكرية (وكم كان يحب أن يكون جندياً لدرجة أنه أستخرج لنفسه دفتر خدمة عسكرية بدل ضاع وانخرط في الجندية ليلتحق بالجيش العراقي المشارك في حرب الأيام الستة عام 196).
يحدثني في ليلٍ بهيم تعطره رائحة الطبيخ المتسلل من شارع قبيلة الحلاف عن الطائرات الإسرائيلية التي قصفت الأرتال العسكرية العراقية وهي لا زالت في الرمادي وكيف أنّ المدافع الرشاشة كانت مجرد دمىٍ حديدية لا تطلق النار، فالحكومة آنذاك لم تزود القطعات الذاهبة للحرب بالذخيرة خشية عودتها للعاصمة بغداد وتكرار ما جرى في صبيحة 14 تموز 1958، وهكذا تساقطت القذائف الإسرائيلية على الأرتال المحنطة مثل دمعٍ طويلٍ يتدلى من عيون وقحة، وهرب الجند تاركين أسلحتهم العاقر تحت مطر القذائف المدمر القبيح.

صوت قارورة الشاي فوق السماور الروسي العتيق تحوّل إلى صفيرٍ حاد، إيذانا بأن كل ما في القوري قد تبخّر، ونهض مهدي متردداً في أن يقاطع حديثه، وسكب ما في القارورة، وأعاد تخدير الشاي للمرة الرابعة، لعلها كانت ليلة الهرير في ضيافة أبو مهدي بصومعته الغريبة. جلس أبو مهدي، في زاويته مقرفصاً، وأوقد لنفسه سيجارة، ودون سابق إنذار انتقل في الحديث من الحرب إلى الصلاة، وشرع يحدثني عن صلاة الواحد وخمسين التي يقضي بها ليله، لا يهمه أن يبني بيتاً ولا أن ينتمي لأهلٍ ولا أن يبقى له امتداد، فكل امتداده الآن هو اتصال غيبي بالسماء طالما تحققت إشراقاته في ليالي البرد المعتمات، فأصاب بها رؤىً خاطبه فيها أولياء صالحون كثر لدرجة الانكشاف، يروي لي وقائع الانكشاف، فيما يغمر الألق الميتافيزيقي غرفته الفقيرة الصغيرة المعتمة.
في الزاوية يقف ظلٌ غائم الملامح يحرك يده بشكل دائري وباليد الأخرى يحمل مصباحاً تنوس شعلته بقبس أزرق، زيته ذهبي اللون ونوره ساطع يتلألأ دون انتماء ودون اتجاه ودون قرار ودون مدى. زيت المصباح مادة من قلق زئبقي لاتشبه كيروسين الإضاءة ولا غيره من الوقود ولكنها تتقد كما لو أنّ فيها إعجاز غيبي. هكذا يشعر الحاج مهدي، وهكذا أوحى إليّ وأنا جالس أسامره في بيته ذي الأربعين مترا في هذا التيه اللامنتمي.
أجيالٌ من سكان المدن الصغيرة التي صارت محطات في حياة الحاج مهدي تزوجوا وانجبوا، وشارك هذا الرجل الغريب الناس أفراحهم وحضر أعراسهم وقرأ الفاتحة في مآتم غيرهم (بعد كل وفاة تنتابه حالة اكتئاب وانطواء حاد)، ثم لا يلبث أن يعود لجولاته اليومية التي تقوده إلى مناطق محددة. لا تتجاوز السوق الصغير الفقير لدرجة أنّه يحتفظ دائماً بإسمنت أرضيته نظيفاً، بيت الاستاذ هاشم، حديقة حسين العراقي حيث يجلس الأخير غارقاً في تأملات رحلته العجيبة وهو ينفث دخان نارجيلته الغليظ من منخريه مثل قطارٍ غاضب، وهو غاضبٌ من أبن أمه الموظف الكبير في المدينة القريبة الكبيرة لأنه لا يسعى لإنقاذه من هذه الغربة الكافرة. ويذهب مهدي أحياناً إلى حمام الحاج حسن، ومسجد المدينة الصغيرة ثم يعود لغرفته- بيته المهملة، ولقدور الطعام التي لا تعرف اللحم، وللصحون المعدنية القبيحة الرخيصة ولقطع الأثاث البائسة، وهي ليست أكثر من تلفزيون قديم متداعٍ أعاره له صديق مضى إلى العالم الآخر ومدفأة كهربائية عتيقة ابتاعها بثمن بخس وصندوق لحفظ الملابس التي يتصدق بها سكان المدينة وفراش يتّسد الأرض وقد أبلاه الزمن وتعاقب الأجساد عليه وثلاثة أكيس جنفاص من الكتب، يبحث أغلبها عن غلاف ومؤلف!
عصر ذات يوم ربيعي، قرع باب بيتي المهلهل، رافقته إلى السوق وتناولنا قطعتي حلوى وشراباً مثلجّا، ثم رافقته لنطوف بأرجاء المدينة. قرب الجدول اليتيم نفترش أجمة خضراء تسبح في بحر من الحنطة، الأفق المسفوح أمامنا يمتد يانعاً باذخاً يمتص نهايات كلماتنا لينتهي بجبال جرداء شوهاء تقرر رغماً عنه اتجاهه.
صفن حديثنا برهة تطاولت زمناً أتكاسل أن أقيسه خشية أن أجرح صفاء الهدوء الجميل، وأتذكر مولانا المغرق في حب شمس الدين التبريزي، هل كان يحار في لحظات الصمت الطويلة مع معشوقه الأبدي؟ بكى الحاج مهدي بحرقة وبدمع كبير حقيقي، بكى بأسى لا يشابه أسى الآخرين، بكى فألجمني صمتاً ودهشة وذهولاً، ليس هيناً أن يبكي رجل في الخامسة والسبعين خلف عمره جبال من تجارب، ولا يسع المرء أن يقول شيئاً يكسر به حاجز الخجل الداهم، فأبقى صمتاً وتنتابني رغبة في البكاء والسؤال!

يصمت الحاج مهدي ويكفكف دمعه ويخاطبني بصوت أجش خنقته العبرات مثل رجل يستيقظ تواً من حلم: أنت لا تسألني عن سبب بكائي!؟
لا حاجة لذلك، لا يبكي رجل في الخامسة والسبعين إلا لسبب لا يصح السؤال عنه!
لم أبكِ قبل اليوم أمام أحد، معذرة!
ليتني استطيع البكاء، فخلفي أوقيانوس حزن سحيق.
أتدري؟ أنا أبكي لأني أتأمل حياتي فلا أجد نفسي طيلة عمري قد خالفت القانون مرة واحدة، أنا لم أقف ضد السلطة مرة واحدة، بل أنني لم أخالف حتى قوانين المرور، ولا شأن لي بالسياسة في كل الأزمان، لا الملك ولا الزعيم ولا العافين ولا البكر ولا صدام ولا خميني ولا خامنئي، لم أعرف لنفسي اهتماماً يتجاوز الخبازة وهي مهنتي والعبادة وهي آخرتي والقراءة وهي متعتي بعيداً عن كتب السياسة، بل لم أكن ألعن السلطة حتى في خلوتي! ومع هذا جاء رجال الأمن قبل 23 عاماً واقتادوني إلى الحدود، ثم ألقوا بي إلى هذا البلد، وقالوا: اذهب لوطنك!
في جيبي آنذاك عشرون ديناراً، وكل ما عليّ هو قميص أبيض قديم وسروال أسود داكن وانتعل في قدمي حذاء بالياً أحمر اللون. ومنذ ذلك اليوم بت لا أحد، دون هوية ودون وطن، حتى ظهر اليوم حين ذهبت إلى المدينة الكبيرة القريبة من هذا المنفى، فالتقيت صدفة برجل ألقت به السماء في طريقي.
يمر قطار الساعة السادسة للمسافرين ليقاطع حديث ندماء الغربة، ما أحلى أن تسكن قرب سكة القطار وكلما مرّ يجرجر عرباته المحمّلة بآلاف القصص والأماني والأحلام والمسافرة أبداً في رحيل لا ينقطع شمالاً وجنوباً، صاعداً نازلاً مثل مسرى الدماء في العروق، تسافر أفكارك معه وأنت المحروم من السفر منذ عقود، فيحمل جزءاً منك لغاية لا تقصدها، (وقد لا تراها قط)، وهكذا تمسي رجلاً لكل المحطات وكل المدن التي يمر بها قطار المسافرين !
صوت العجلات بإيقاع رتيب متصل يقطع صمت الوادي الفسيح بقراه ومدنه الساكنة في دعة وهدوء يسمان الريف في كل أقاليم العالم. احتكاك العجلات بالسكة الحديد يقاطع حديث الحاج مهدي فيوقد لفافة تبغٍ رخيص رطب، يضعها في مبسمه الخشبي المتفحّم، ثم يدس المبسم في فمه الأدرد ويمتص الدخان الغليظ بشوق، عيناه تنظران إلى القطار بغيظ وصبر نافذ. تتكدس الكلمات على شفتيه وهي تلعن في صمت صوت القطار، وحين اقتربت ماكنة القطار من محطة القصبة المجاورة، أطلقت صافرة طويلة حادة، ثم أعقبتها بصفير متقطّع وبدأ القطار يتباطأ استعداداً للوقف، وأخذ صوت العجلات يتلاشى فيرتفع صوت الحاج مهدي ثانية يروي لقاءه بالغريب في المدينة الكبيرة القريبة:
هذا الرجل بعد أن حدثني طويلاً أخبرني أن اسمه عبد الهادي جواد، مردفاً (هل تدري أن أسمي هو عبد المهدي جواد؟)، ثم عاد وأخبرني أن لقبه هو(باب الثلج)، مضيفاً: لم أسمع بلقب مثل هذا قط ولكني فرحتُ لأني عثرتُ على أخي أخيراً ومنه عرفت لقب عائلتي!
أدهشتني قناعته الشاسعة وأثار استغرابي اطمئنانه إلى أنّ ذلك الغريب الذي كان جالساً إزاءه هو أخاه! فسألته: كيف عرفت أنّه أخوك، هل يكفي تشابه الأسماء؟
القلب يعرف، إنه قريبٌ إلى روحي، قريب جداً، أهو قدري أنّ المعارف والعلوم تعجز عن تحديد مثل هذه الأمور؟ حتى لو كان الإنسان عارفاً متعلماً فإنّ علومه لن تسعفه في مثل هذه الموارد.
جاريته في سياحته الفكرية المرتبكة المتقافزة من موضوع لآخر، حيث خيوط ذكرياته يختلط فيها الواقعي بالمتوهم، والحقيقي بالعجائبي، والفلسفي بالخرافي، والسماوي بالأسطوري وسارعت أسأله: هل يشبهك هذا الرجل؟
يا سيدي هذا ليس مهماً، هل يتشابه الأخوة دائماً، بيننا شيء مشترك، شيء لم أجده لدى الآخرين، فهو وحيد يبحث عن أخاه منذ أربعين سنة، عمره يقترب من الستين ولا أهل عنده، هل تدري كيف يكون الإنسان دون أهل، عارياً مثل حصاة ترقد في قعر نهير جارِ المياه وحيدة ساكنة في القاع والماء يجري بلا انقطاع.

هل تعني أنّك قررت بنفسك أنّه أخوك؟
أجاب وهو ينفث مزيداً من الدخان الرديء: كلانا فرح بلقاء أخيه، ألا تكفي فرحة شيخين عنواناً للأخوة؟
بعد أسبوع زارني الحاج مهدي في ليلة مطيرة، قرع الباب ودفعه ليدلف دون استئذان وهو يتمتم أدعية وتحاياً غامضة. ما إن جلس إزائي حتى انقطع التيار الكهربائي (التيار الكهربائي في الأرياف غريب الأطوار وفي خصام مستمر في مع عوامل الطقس).
أوقدت فانوساً عتيقاً وعلى ضيائه أخبرني أنّه راحل عن مدينتنا المشوهة الرعناء إلى المدينة التي يسكن فيها أخوه، وأوصاني أن لا أخبر أحدا بمقصد سفره، وأعطاني كتاباً عن الأرواح، ثم غادرني على أن يسافر في الغداة ويمر بي ليسلمني مفتاح داره.
في اليوم التالي، وقفت أمام بيتي سيارة حمل صغيرة تحمل أثاث الحاج مهدي، قرع باب بيتي وسلمني مفتاح داره، وسألته لماذا لم يعد المفتاح إلى دائرة البلدية وهم أصحاب الدار؟
فقال: من يدري ربما لا أحب الحياة مع أخي عبد الهادي، وقد لا يكون أخي! ولكن لابأس أن أجرب وأترك لنفسي سفينة أعود بها إلى شاطئكم الفقير المقفر، لا ينبغي أن يحرق الغرباء الأشرعة ولا أن ينسفوا جسور العودة خلفهم حتى إذا وجد أحدهم شقيقاً له!
حين أقلعت السيارة به، كان الحاج مهدي يبتسم ملء فمه ويلوّح بيده، أتطلع بمفتاح الدار لأجد قطعة قماش من قميص الحاج مهدي الأخضر قد شُدت إليه، أضعه في جيبي وأدلف إلى بيتي وبي رغبة أن أكلم الليلة أخي الغارق في ثلوج شمال أوروبا، لعله ينقذني من هذا القفر التائه .
مخيم إبراهيم آباد- ملهم الملائكة/ ربيع 2002






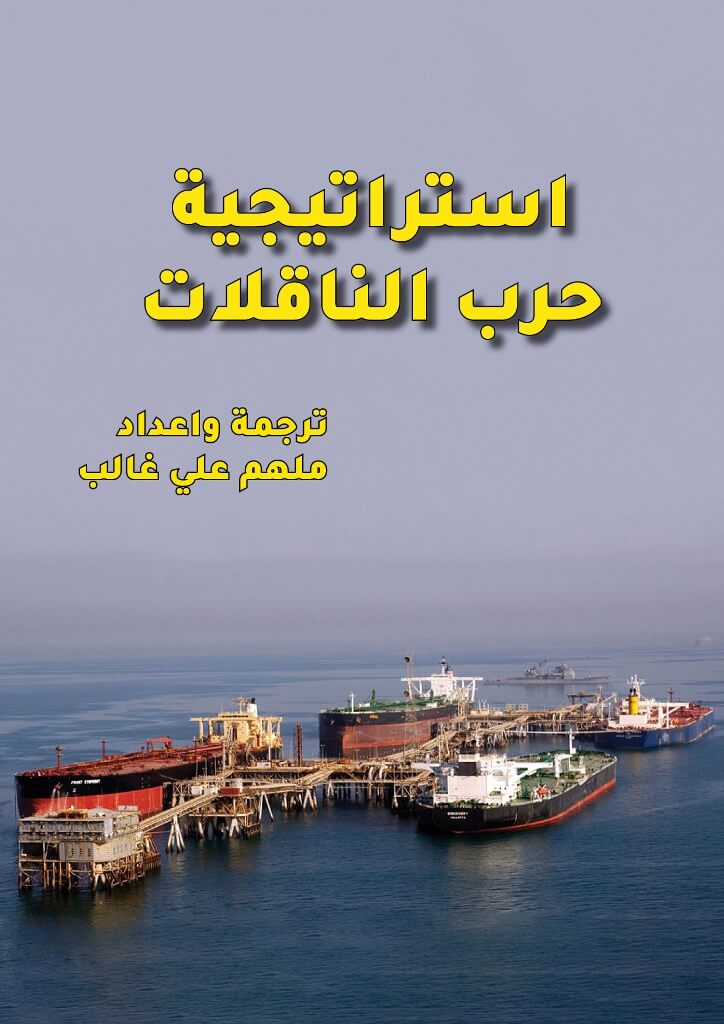
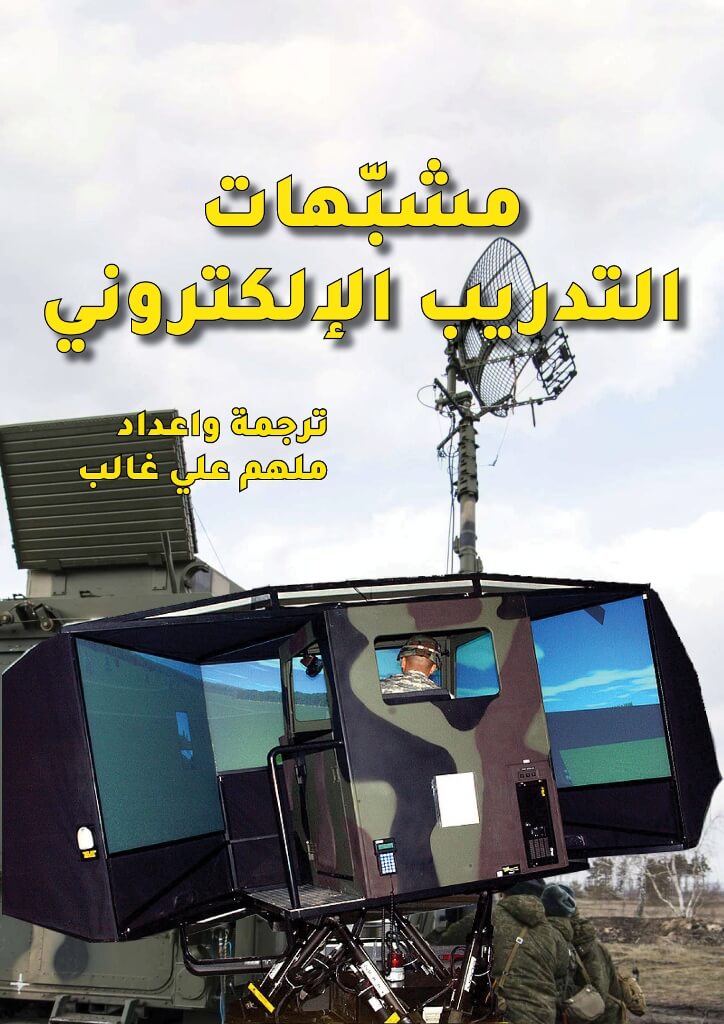
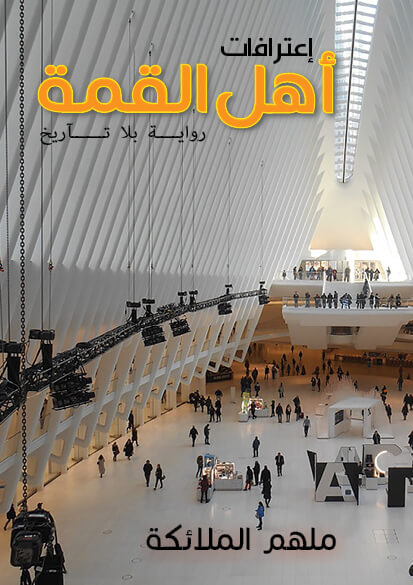




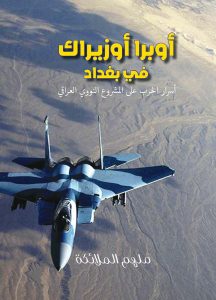
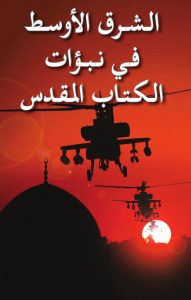








0 تعليق