أجمل ما في جمهورية مالطا، أن كل شيء قريب منك، وكل شيء تدركه بلا جهد، والانتقال من المطار إلى المدينة وبالعكس يستغرق بضع دقائق. وهكذا اخترت اليوم أن أصل مطار الجزيرة في وقت مبكر، ففيه مطعم جميل يقدم مآكل شهية من مختلف مطابخ العالم، كما أن وصلة الانترنت فيه قوية وتدخل ضمن عروض المطعم، وعلي اليوم أن أرتب تقارير نهاية رحلة العمل المزدحمة التي انتهت في مالطا بلقاء صديقي القديم جيري وصديقته المالطية ماغي.
تناولت طعامي متمهلاً ، وحال أن انتهيت منه، شرعت أعمل على اللاب توب، أمامي نحو 3 ساعات حتى إقلاع الطائرة، وهذا يكفي لإنجاز التقارير. وسط انشغالي اقترب مني نادل يافع حليق الوجه في وقت يطلق فيه أغلب الشبان لحاهم وشواربهم بكثافة، ثم استأذن مني ليرفع الصحون عن مائدتي.
غرقت في العمل لنحو نصف ساعة، وفجأة بدأت وصلة الانترنت تضعف، فتلفت أبحث عمن يمكن أن يساعدني في حل المشكلة، ومرة أخرى اقترب مني الشاب اليافع الحليق، وسألني بإنكليزية ضعيفة إن كانت وصلة الانترنت لا تستجيب!؟ ابتسمت لأنه أدرك مشكلتي، فأومأت براسي إيجاباً، وقلت له أعتقد أنهم رصدوا وقتاً محدداً لكل زبون؟ ابتسم هو الاخر وسألني بعربية أهل العراق إن كنت أتكلم العربية، أجبته بلهجة بغداد: بلي يا عيني، وأهلا بالعراقيين الذين ألتقيهم عبر العالم حرفياً في كل مكان!
انبسطت أساريره، وأنطلق يتحدث بلهجة بغدادية فيها بعض الثقل وقال: صاحب المحل حدد مدة جلوس الزبون بنحو ساعة، وأنت قد تجاوزت الساعة، أفضل حل هو أن تحول كابول الربط ب”واي فاي” إلى الوصلة المجاورة، لن ينتبه أحد لأنهما متقاربتان، وبعد ساعة، يمكنك أن تعود للوصلة الأولى، شرط أن لا يكون زبون آخر قد جلس بقربك وشغل الوصلة.
فعلت كما قال، فتجدد الارتباط وقوي النت، شكرته ووضعت في يده قطعة نقد معدنية من فئة 2 يورو. فاعتذر عن أخذها، مشيراً بلغة تملؤها العاطفة أنه سعيد للقائه بعراقي يحدثه بلغة بلده، وأضاف مؤكداً بإصرار “خليهه عمي، شكراً لك”!

وتركني أعمل، واتطلع بين وقت وآخر إلى لوحة توقيتات الرحلات المغادرة والوافدة متابعاً توقيت رحلتي المرتقبة. وبعد نحو ساعة أخرى، أعلنت اللوحة، أن الطائرة المغادرة إلى اسطنبول-التي سوف استقلها- ستتأخر رحلتها نحو ساعتين!
في نفس الوقت بدأت وصلة الانترنت عندي تضعف، فسارعت أنقل الكابل إلى الوصلة الأولى، فقويت الشبكة، واقترب مني الشاب العراقي مبتسماً وفي يده فنجان قهوة وهو يقول بود” عمي القهوة تناسب الشغل، انتبه أن لا تفوتك طائرتك!”
فاجأني كرمه، فسارعت أدفع له بورقة 10 يورو، قيمة القهوة مع البقشيش لخدماته الرائعة، لكن الرجل رفض بإباء، واقترب مني وهو يقول: عمي لا أريد منك سوى أن تسمع لي، ففي داخلي قصة لا أجرؤ أن أرويها سوى للعراقيين لأنهم الوحيدون الذين يفهمونها، هل تسمعني؟
ابتسمت وقلت له، بالتأكيد، قل ما عندك!
وقف قريباً مني وقال: ليس هنا يا سيدي، فالمدير سيراني أتحدث إليك طويلاً وقد يعاقبني، هل يمكن أن تخرج إلى صالة الانتظار، حيث قاعة المسافرين المغادرين، سآتي لك وأجلس معك نحو ساعة لأحدثك، ممكن؟
نظرت في لوحة الرحلات، فوجدت أن أمامي نحو ساعتين ونصف حتى اقلاع الطائرة، وما زال في يدي تقرير أخير يجب أن انجزه، فقلت له: نعم ممكن، لكن امنحني نصف ساعة حتى أنجز ما في يدي، وسأذهب إلى صالة الانتظار لنتحدث على الرحب والسعة.
غادرني مبتسماً بانشراح، وانهمكت في كتابة التقرير، فاستغرق ذلك نحو 40 دقيقة، رزمت بعدها اللاب توب، وأخذت امتعتي مغادراً إلى صالة انتظار المسافرين المغادرين، حيث انتخبت مقعداً في آخر الصالة، يطل على مدرج الطائرات، وجلست انتظر ورود “محدثي” العراقي الغريب.
بعد دقائق، جاء الشاب، وسارع يجلس قربي ويمد يده لي بالتحية وهو يقول: علي إبراهيم، من بغداد!
أخذت يده أشد عليها محيياً، ورددت مبتسماً دون أن أعلن اسمي، بل عرّفت نفسي بالقول: أهلاً وسهلاً بك، تشرفت بمعرفتك، أنا أبو صباح!
جلس إلى جانبي، فأخرجت هاتفي المحمول وقلت له: هل تسمح بأن أسجل ما ستقول، أنا لست صحفياً، بل أسمع قصص الناس، وأسجلها عندي للمستقبل، ربما كتبت بها رواية في زمن ما!
بدا على وجهه الحزن وهو يقول: بل أنا يهمني أن تنشر قصتي، عسى أن يسمعها من يمكنه حقاً أن يحل مشكلتي!
شغلت تطبيق التسجيل، فقال علي: بدأت الحكاية عام 1980، فقد قرر صدام حسين أن أهلي ذوو تبعية إيرانية، رغم أنهم عراقيون من الكرد الفيلية، وهكذا فقد نقلت حافلة عسكرية جدي وجدتي وأمي وخالاتي الثلاث إلى الحدود في منطقة يقال لها ميدان، وتركوهم يسيرون ليلاً باتجاه إيران بعدما أخذوا معهم فقط ما تمكنوا من حمله، وهكذا فقدنا بيتنا في محلة الكاظمية ببغداد، وفقد جدي محل بيع السجاد الخاص به في سوق السجاد بشارع المصارف بقلب بغداد. أنا طبعا لم أكن قد ولدت آنذاك، لكني سمعت القصة من أهلي. أها…وفاتني أن أذكر أن الشرطة اعتقلت خالي حيدر وكان عمره آنذاك 19 سنة وهو طالب في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد، ووضعوه في سجن التسفيرات، ولم نسمع خبره منذ ذلك التاريخ.
تضاعفت المأساة حين وصل أهلي إيران، فقد وضعوهم في مخيمات المسفّرين ويسمونهم في إيران “معاود” وبلغت أعدادهم كما سمعت عشرات الالوف، واستقر أهلي في مخيم بمدينة كرج جنوب العاصمة طهران، وحلوا كلهم في خيمة واحدة لمدة نحو 6 أشهر، ثم منحوهم غرفة في ما يعرف ب “اردوكاه” وتعني مضيف مؤقت للوافدين.
تطاولت الأيام، ولم تُحل مشكلتنا، فالمسفرين من العراق وأغلبهم من الكرد الفيلية نوعان، القسم الأكبر منهم، لديهم صحائف في السجل المدني الإيراني، لأن جدودهم ذوو أصول إيرانية، وقد هاجروا إلى العراق قبل عقود، تصل أحيانا إلى مئة سنة، لذلك، جرى منحهم وثيقة تثبت أنهم إيرانيون ريثما تصدر لهم الوثائق الرسمية.
أما الأقلية التي لا تملك صحفاً في السجل المدني الإيراني فهم عين المأساة. العراق طردهم باعتبارهم إيرانيين، وإيران ترفض استقبالهم وتجنيسهم لأن أسامي أجدادهم غير مثبتة في السجل المدني الإيراني، وهكذا تعتبرهم إيران عراقيين!
سكت وقد تشعب الحزن في وجهه، فانطفأت شبه الابتسامة التي كانت تلوح على وجهه اليافع الحليق، وعاد يقول بصوت يشبه الهمس: وقامت الحرب، فاشتدت المشكلات على أهلي، وتزوجت أمي بأبي، وهو أيضا من المسفرين الفيلية، وللأسف فقد كان هو أيضا بلا صحيفة في السجل المدني الإيراني، ورزقا ببنتين، ثم توقفا عن الانجاب لأن المولودين في إيران لأبوين لا يملكان أوراقاً ثبوتية تثبت تابعيتهم لا يسجلون في السجل المدني. وحتى زواج أمي بأبي كان زواجاً شرعياً، غير مسجل مدنياً.
عام 1993 ولدتني أمي وقد كانوا يسكنون في مدينة كرمنشاه، وهي من مناطق لرستان الإيرانية التي يقطنها اللر وهي التسمية الفارسية للفيلية. ومن المفارقات أن عمي كانت له صحيفة في السجل الإيراني فكان مواطناً إيرانياً، كما كانت له صحيفة في السجل المدني العراقي، ولذا كانت له حصة تموينية، كان يعبر الحدود كل شهر ليستلمها من خانقين! ويعود ليعطيها لعائلة أخيه أي عائلتي وقد كنا نعاني من ضيق اليد.
كبرت في كرمنشاه بلا مستمسكات، ولم يتمكن أهلي من تسجيلي في مدرسة، لكن أبي تمكن أن يلحقني حين بلغت العاشرة من العمر، بمدرسة دينية عراقية في قم، كانت تقدم دروساً حوزوية للعراقيين مجاناً وتؤمن لهم مبيتاً وحداً أدنى من الحياة. في تلك المدرسة اتقنت التحدث والقراءة والكتابة بالعربية. وفي عام 2003 اسقطت أمريكا صدام حسين، فعدنا إلى العراق عام 2004، وحاول أهلي أن يستخرجوا لهم صحيفة في السجل المدني العراقي بلا جدوى، فسكننا في كردستان بلا مستمسكات، وفي عام 2011 قررت الهجرة إلى تركيا، وخرجت عن طريق التهريب، واشتغلت في العديد من المدن التركية، لكنّ لعنة عدم امتلاكي لهوية ظلت تلاحقني أينما ذهبت، حتى يئست من البقاء في هذا البلد، فغادرته عام 2014 إلى مالطا عن تطريق التهريب بالزوارق، وها أنا أعيش في هذا المكان منذ ذلك التاريخ!
توقف عن الكلام، وعلى وجهه ملامح ألم وحسرة، وكان ما رواه صاعقاً حقاً، فسألته عن أوضاعه في مالطا، وهل قدم على طلب لجوء أم لا، فجاءت إجابته صاعقة إذ قال: أنا لست في مالطا، انا أعيش منذ ورودي للجزيرة في هذا المطار، أمارس أعمالاً متنوعة، أغلبها في التنظيف وخدمة المطاعم، وأعيش بشكل غير قانوني في المطار، لدي مكان أنام فيه مع مجموعة عمال البناء والصيانة، وأحيانا أنزل إلى المدن فأتجول وأعود صباحاً لأدخل المطار بالحافلة التي تجلب عمال الخدمات، وهذه النزلات محفوفة دائماً بخطر أن أنكشف ويأخذوني للحجز، ثم يسفروني، وقد حدث معي مثل ذلك في تركيا، فحجزوني وحاولوا أن يعيدوني إلى العراق فرفض العراقيون استقبالي لأنني لا أملك جوازاً عراقياً، ثم حالوا أن يعيدوني إلى إيران، فرفضت إيران دخولي لأني لا أحمل جواز سفر إيراني، وفي النهاية خففوا من إجراءات الحجز علي فهربت وجئت إلى مالطا!
ذهلت لما قاله، وسألته مرة أخرى كم سنة هو على هذا الحال، فقال إنه في المطار منذ 3 سنوات، ولا يجد أفقاً يشجعه على مغادرة المطار.
سافرت بي الأفكار ذاهلاً مع رحلة هذا الرجل، جاوز عمره ربع قرن وما زال بلا هوية، يتنقل بين البلدان وهو لا شيء، قانونياً هو غير موجود! إنسان لا وجود له رسمياً! أي عالم غريب عالمنا؟ يعني الورقة الرسمية أهم من وجود الإنسان. عدت أسأله: ماذا تنوي أن تفعل، لماذا لا تطلب اللجوء، فأوروبا تمنح اللجوء الإنساني للقادمين من بلدان الحروب.
أجابني أنه ينوي أن يفعل ذلك، لكن عليه أولاً أن يصل ألمانيا، وهناك يعلن لهم أنه سوري هارب من حلب مثلاً، ولا يملك أوراقا ثبوتية، وقد يمنحوه لجوء يتيح له الحصول على هوية!
أطفأت تطبيق التسجيل، وشكرت علي وصافحته مودعاً وقد ألح في أن أنشر قصته لعل أحداً “من المسؤولين” في أي بلد يلتفت لمأساته ويغيثه.
انتهت قصة علي إبراهيم الحزينة التي لا تشبهها قصة، فهو ضحية الهجرات، والبيروقراطية واختلافات السياسة، وجهل الأهل الذين أنجبوا ولداً دون أن يهيئوا له مساحة قانونية في الحياة!






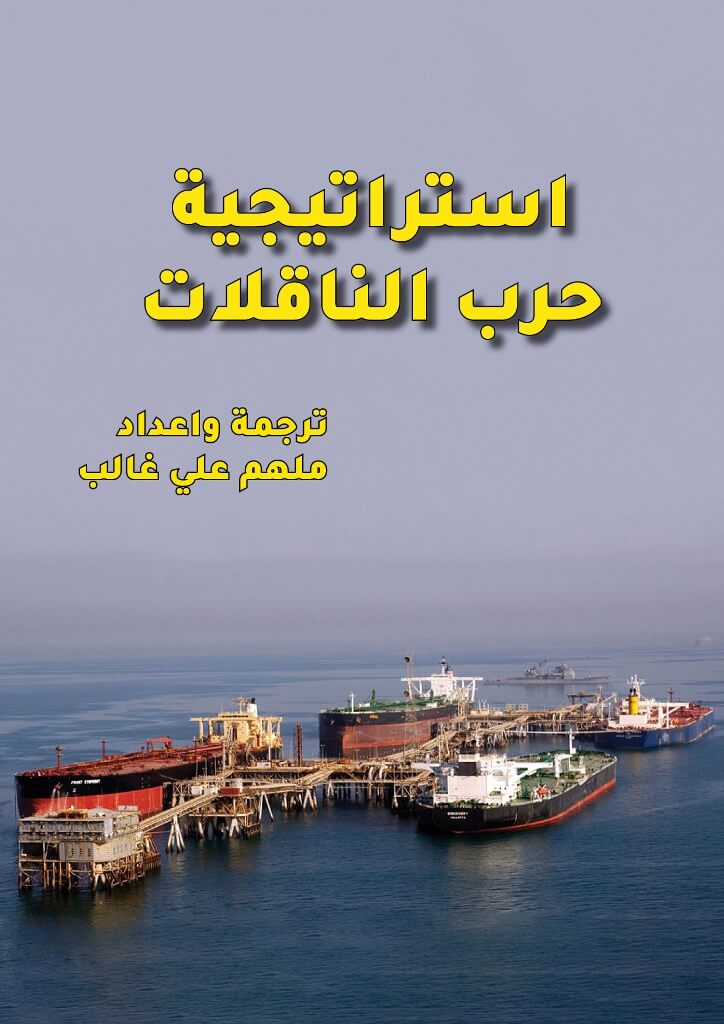
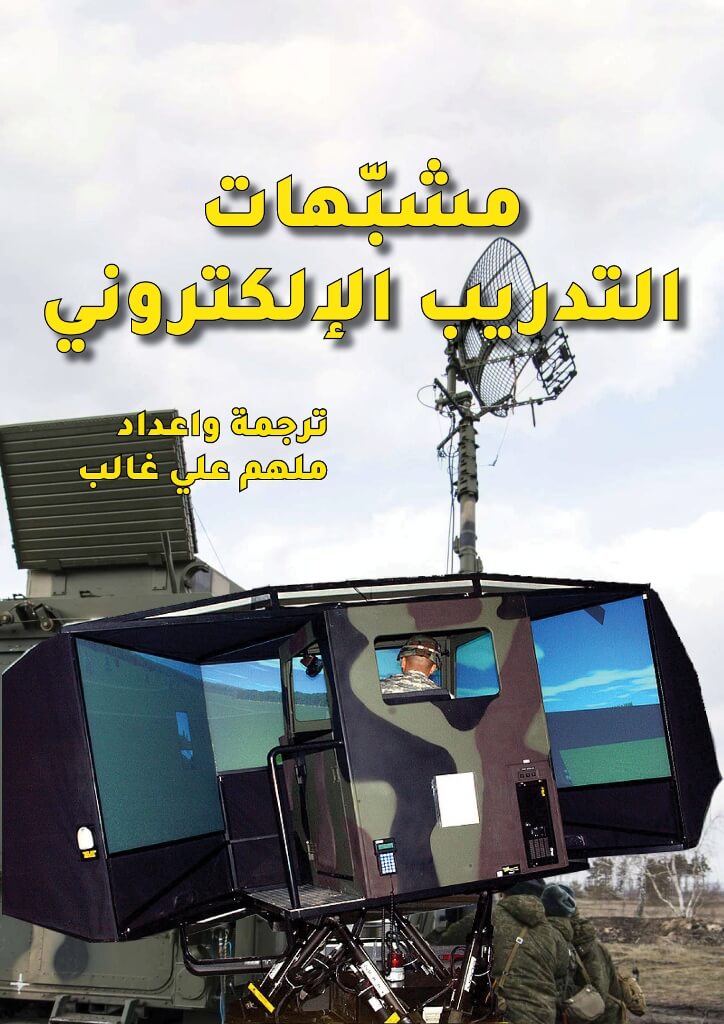
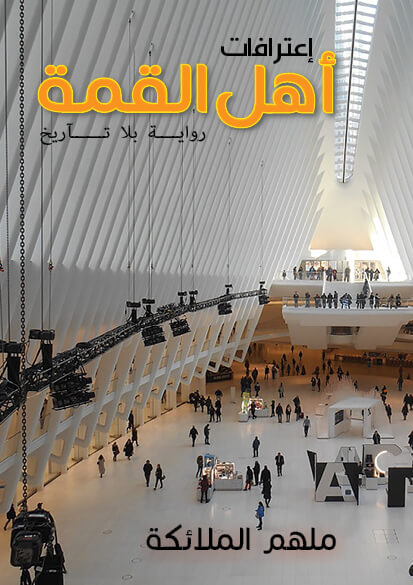




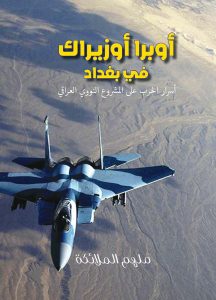
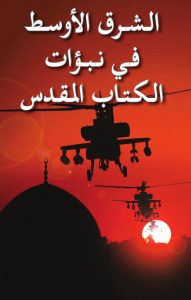








0 تعليق