يتوقع المرء أن التعامل مع النساء أسهل في بعض المواقف، لكن هذا ليس دائماً صحيح، إذ يستند ذلك على نوع المرأة التي تتعامل معها. هذه قصص 3 نساء زرن مكتبي في مناسبات مختلفة، وتعلمت منهن دروساً هامة.
العراقية
رن هاتفي، فأخبرني موظف الإستعلامات الألماني – البولوني، أنّ ضيوفا من العراق ينتظروني في الاستعلامات. حين وصلت، التقيت إمراة في أواخر ثلاثينياتها ملتفة بالسواد من رأسها الى قدميها، وبرفقتها رجل في مثل عمرها وآخر في أول عشريناته. المرأة قدمت نفسها بعنوان “سياسية من الكتلة…” ولم تمد يدها لمصافحتي لأنها أنثى! وأنا رجل غريب، فيما فعل عنها ذلك المرافقان لها.
في مكتبي شكت “السياسية العراقية” من إرتفاع سعر رحلتها على طائرة لوفتهانزا، فسألتها لماذا لم تأخذ طائرة الخطوط الجوية العراقية، فقيمة رحلتها الى المانيا أرخص بست مرات من اللوفتهانزا؟
قالت: ” كيف أطير على العراقية وهي لا تملك مواعيد ثابتة للسفر ولا مكتب ثابت ولا طاقم تضييف، كيف أطير على طائرة مؤسسة فاسدة من مخلفات البعث! وكيف أطمئن من إجراءات السلامة وانا أعرف حقيقة كل ما يجري في مطار بغداد الدولي …”مثل الصدك”! ثم قالت “أنا هنا لست للعمل، ولا أريد حديث سياسة، بل أنا في زيارة علاج”. تراجع مؤشر الحماس الصحفي عندي فسألتها ماذا بوسعي أن افعل لها؟
قالت: “العراقيون يساعدون بعضهم، وأنا في حاجة الى مساعدتك لدخول المستشفى”.
وعرفت منها أنها لم تُجر حجوزا مسبقة للمشفى، وهذا يعني استحالة دخولها اليه ما لم تكن محمولة على سرير الطواريء، وهكذا أخبرتها فلم تقنع. إتصلت بالمشفى المعني فقالوا: إنّ مواعيد الأيواء عندهم محجوزة حتى شهر تموز/ يوليو العام بعد المقبل، ولا يقبلون إلا الحالات الطارئة.
حين قلت لها ذلك، قالت ألا يمكن معالجة ذلك بمبلغ مالي؟
كلمتهم مرة أخرى، وقلت لهم إنّ المريضة مستعدة لدفع مبلغ إضافي لإدخالها، فلم نصل الى اتفاق لجسامة المبلغ الذي طلبوه. بعد محاولات فاشلة عديدة استغرقت نحو ساعة، قلت للسيدة إنّ وقتي لا يسمح بأكثر من هذا، وإنّ عليها العودة الى ألمانيا في وقت آخر بعد إجراء الترتيبات اللازمة مسبقاً.
غضبت ونهضت من مكانها وهي تقول بحنق ظاهر: “قال لي كثيرون لا تذهبي إلى ألمانيا للعلاج، ونصحوني بالذهاب إلى الإمارات، وكان عليّ أن أستمع الى نصيحتهم”، وخرجت ومرافقاها غاضبة من عندي بلا وداع كأني المسؤول عن عدم قبولها في المستشفى، خرجت وهي تجر عباءتها السوداء مثل شراع آخر للخيبة والفشل الذريع.
تعلمت من” السياسية العراقية” أنّ الفوضى والإنفعال واللامسؤولية أضحت هي المبادئ السائدة في عرف ساسة العراق الحزين، وأنّ العراق يكاد يخلو من نخب يمكن أن تقود شعبه إلى بر الأمان والاستقرار، وأنّ أغلب أفراد النخبة السياسية هم أسوأ ما في عراق اليوم وهم سبب خرابه.
التونسية
عرفتها من خلال صفحة فيسبوك، سيدة أعمال تونسية كثيرة التنقل والحركة، وكل يوم تضع بوستاً لها من مكان عبر العالم. وحين قرعت باب مكتبي، لم أميزها فوراً، فقد كانت صورتها على فيسبوك قديمة. سيدة في خمسينياتها، تتقد حيوية، وتتحدث بأربع لغات، أنيقة بما يليق بأنوثة الخمسين، ومؤدبة بما يليق بسيدة أعمال تتعامل بملايين الدولارات على مدار الساعة. وحدها تجوب العالم، دون مترجم، ودون مرافق ودون دليل.
حين اقتربت مني صافحتني بحماس، وهي تقول “في النهاية التقينا، بعد 3 سنوات على فيسبوك، ها نحن نلتقي في ألمانيا، وهذا يلزمه ليس مجرد مصافحة بل قبلة وعناق”، ثم عانقتني وبادلتني القُبل بحرارة معرفة عمرها 3 أعوام في العالم الإفتراضي.
حين جلست الى مكتبي، اعتدرت مقدماً وهي تقول” لا أريد أن أعطلك عن عملك، وأعرف أنّ الصحفيين غارقون في المشاغل، أردتُ فقط أن أرى صديقي العراقي الذي يرسل البوستات الجميلة على فيسبوك، ولن أطيل الزيارة “.
حدثتها عن محاولة الانتحاري التونسي تفجير نفسه قرب ضريح الحبيب بورقيبة (وكان حدث الساعة)، فاحمرّت غضباً، وصارت تقول بحماس لم أعهده في سيدات الاعمال:” هؤلاء الحمقى يتهموننا بعبادة الأصنام، بورقيبة ليس صنماً، هو الذي جعل من تونس بلداً لا يشبه بلدان العرب، وهو الذي زرع في نفس كل تونسي أصيل حب الوطن المحايد المجرد عن الأهواء، وهو الذي علمنا أن الأوطان تبنى بتحرير الأمهات وتعليمهن”.
وحين سألتها عن كثرة الإنتحاريين التونسيين التي تجتاح العراق وسوريا وليبيا والصومال وتقتل أهلها، فسرّت ذلك بالقول” في كل مجتمع يحاول الفاشلون أن يجدوا طريقا يخربون به التناسق الاجتماعي السائد، وهؤلاء الفاشلون هم فضلات تونس العلمانية، وهي فضلات ضارة مؤذية، ونحن نفكر في طريقة للتخلص منها بشكل لا نضرّ فيه الآخرين”.
حين غادرتني بعد نصف ساعة وهي تطوي بأناقة معطفها الثمين على ذراعها، ودعتها وقد أيقنت أنّ تونس تسير في طريق التغيير الصحيح، والفضل في ذلك للنخبة من الشعب، فهم يغيرون الناس ولا يتركونهم فريسة للأحزاب الشمولية والمؤدلجة تعبئهم كما شاءت لتمرير خططها.
المصرية
دخلت الى مكتبي، بسروال جينز ضيق يلتصق بساقين نحيفتين، وببشرة سمراء داكنة، تشبه سحن أهل النوبة بين مصر والسودان. ظننتها من أرتيريا وانشغلت عنها ثم انتبهت الى أنها في نهايات عشرينياتها، ولفت نظري جسدها الناحل شبه الرشيق، فظننتها ما زالت بنتاً، وسارعت تنفي ظنوني التي باحت بها نظراتي وهي تقول: أنا صحفية مصرية وأم لبنت عمرها 5 أعوام. بهذا رفعت عني وزر مجاملة البنات وتعاملت معها كامرأة ناضجة.
جرّنا الحديث الى بيتها، فقالت إنها كانت متزوجة من مصور تلفزيوني سلفي (مختص بتصوير كليبات راقصة لمطربة عربية شهيرة!)، وإنه أجبرها على ارتداء النقاب، ثم كشفت لي أنها كانت سلفية تكفيرية.
ضحكت وأنا أتخيلها سلفية منقبة ناظرا الى ملابسها الغربية الأنيقة، فضحكت هي الأخرى وقالت: “إنّ الله يهدي من يشاء ويظل من يشاء، وقد هداني فاكتشفت أنّ الجنة السلفية التي وضعني فيها زوجي هي جزء من جحيم الوهم، وحين جاءت الثورة، وخالطت الناس، عرفت الى أي حد كنت مظللة وتائهة، وعرفت لماذا كان زوجي يضربني كل خميس، وعرفت أشياء كثيرة من ميدان التحرير الذي لازمته أسابيع طويلة، فثرت عليه، وعلى النقاب القبيح، وعلى كل تفاصيل حياتي معه، وأخذت أبنتي الى القاضي وطلبت الطلاق، ثم رميت النقاب، وسرّحت شعري، وعدت امرأة بعد أن كنت قد تحولت إلى مخلوق لا شكل له، وها أنا أقود حملة على فيسبوك وفي الصحف الإلكترونية، لنشر ثقافة نزع الحجاب والنقاب لأنها سبب خراب بلدنا”.
حين عادت السمراء الثائرة إلى وطنها، تعلّمت منها أنّ الثورة المصرية قد غيرت وعي الناس، وتيقنت أن النخب المصرية هي المسؤولة عن التغيير، وتأكدت أنّ تجربة حكم الإخوان في مصر عادت بفوائد جمة على شعبها، وساعدت المصريين على أن يستعيدوا وعيهم ويزيحوا عن عقولهم الوهم العروبي الإسلامي المريب.
ملهم الملائكة






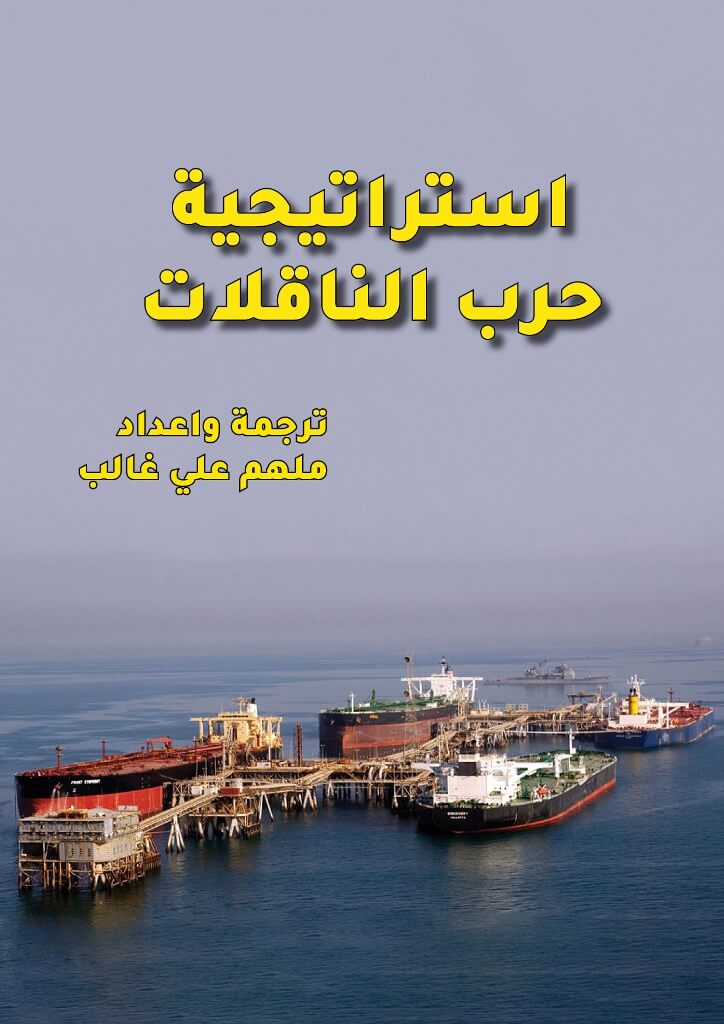
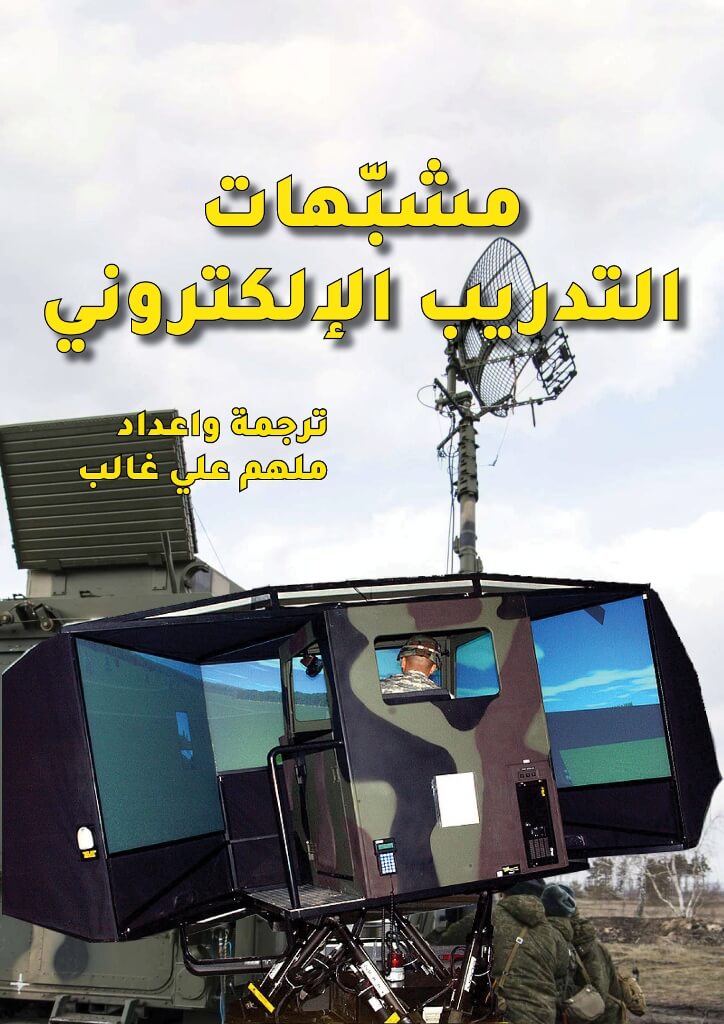
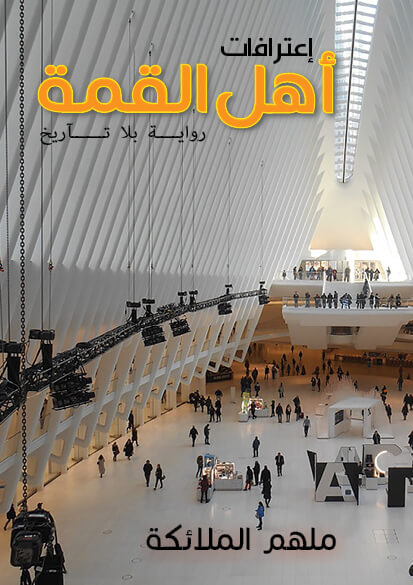




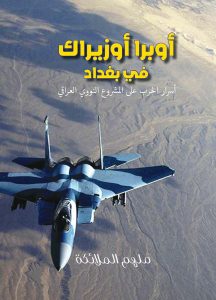
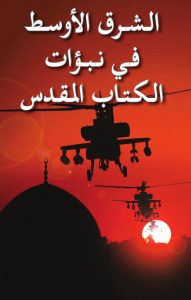








0 تعليق