ليت الحروب بلا مدافع وليت القصف يهدأ، مع كل قذيفة تسقط يموت إنسان ألف مرة، بل يتمنى أن يموت قبل أن يسمع دوي المدافع وراجمات الصواريخ وهي تطلق نيرانها وقذائفها باتجاهه.
لازال وليد يحدثني عن الشتاء الماضي الذي قضاه في القاهرة، وكلما قاطعه صوت إحدى الدبابات وهي تطلق النار، توقف عن الحديث هنيهة ثم عاد إلى نفس المكان الذي توقف فيه وكأنّ صوت القصف موسيقى تصويرية تشكل خلفية حديثه.
لا أستطيع أن أتابع معه قصة رحلته السياحية، يُصدر الجهاز اللاسلكي القريب صوتاً أجشّاً تقاطعه إشارات لاسلكية مشوشة، عليّ أن أتجه بسريتي لتطهير المواضع المحيطة بقصر الأمير بمحض انقطاع القصف.
عصراً بدأ تقدمنا، سكنت تقريباً كل جيوب المقاومة، تقدمنا بالسيارات نحو المنطقة، ترجل الجنود ووزعتُ الواجبات على آمري الفصائل ثم انطلقت بسيارتي نحو جناح الفصيل الأول. بدأ جند الفصيل بالتوغل داخل المنطقة السكنية، أسير خلفهم وأصوات صليات البنادق والرشاشات وانفجارات الرمانات اليدوية والصاروخية تنازعني انتباهي كل حين.
قرب الغروب أدنو من بيت أنيق تهدّمت واجهته الرخامية والدخان يتصاعد من إحدى نوافذه، إلجُّ البيت بحذر، وفي الداخل آثار الشظايا والاطلاقات والزجاج المهشم تلتصق بالجدران والأثاث المحطم. في زاوية الغرفة جهاز تلفزيون مهيب كبير استلقت أمامه دمية كبيرة بشكل دب باندا، أدلف إلى الصالة الداخلية لأجد سلّماً رشيقاً دائرياً يصعد إلى الطابق الثاني من البيت، ارتقي درجاته بسرعة ثم افتح باب الحجرة وأخطو إلى سطح المنزل، اقترب من سياج السطح وأتأمل المدينة الغارقة بالدخان، يتعالى صوت الرصاص والانفجارات من مبنىً قريب، أصغي هنيهة ثم أنثني أتطلع إلى الأسطح المجاورة، لا شيء سوى آثار الشظايا والقذائف والاطلاقات تتناثر فوق السطوح، أدور بنظري في سطح منزل يفصلني عنه منزل مجاور، لأرى حركة في زاوية السلم الخارجي العلوي منه، أدقق النظر ولا أميّز إن كانت حركة سنور أم إنسان وسط كومة أشياء.
أنزل السلالم مسرعاً، ,ادلف إلى المنزل الأصفر الذي لحظت في حركة بحذرٍ، أدور بنظري في أرجاء المكان الممزق بالرصاص فلا أجد شيئاً، أصعد السلم بحذر إلى سطح الدار، مسدسي في يدي، باب السطوح موارب، أدفعه بهدوء وأدخل إلى فناء السطح، فيقتنص سمعي صوت طفل، أقف وكلُّ حواسي تتيقظ لصوت الطفل الذي يثغو، أتقدم بهدوء نحو مصدر الصوت فاجتاز جدار السلم لأجد امرأة تفترش الأرض بملابس النوم وعباءة كويتية سوداء، أمام ساقيها الممدودتين يحبو طفل لا يتجاوز عمره عاماً، أقترب منهما، فترفع المرأة عينيها نحوي، الرعب يلفها والشحوب يكسو وجهها، تمسك بطفلها تضمّه إليها بفزع، في عينيها رجاء وفي فمها المزموم على صرخة، تتساقط زوايا حزن وتوسل. أقف أمامهما واجماً لا أدري اين أخفي مسدسي عنهما، أين أذهب بسلاحي العسكري المقدس في مواجهة امرأة تبكي وتحتضن طفلها الرضيع؟ أضيع بين الخجل والارتباك والمفاجأة، التقط أنفاسي وأستعيد حواسي فانطق بعبارة سلام يلفها الحياء.

قد تجيبني الجدران وربما نطق الموتى ولكنّ امرأة يهزها الخوف ويتلف كرامتها النسوية كأمٍّ كل لحظة هذا الحصار الناري الحربي الرجالي الكئيب لا تجد لغة ترد بها السلام على ضابط من الغزاة القتلة.
وحين ألحّ في السؤال تضع بارتباك ملاءتها السوداء على رأسها وتحاول أن تستر وجهها وأجزاءً من قميص النوم الذي أجبرها الهجوم المباغت أن لا تغيره، حين دخلت القطعات العراقية أرض بلادها الكويت الزرقاء.
لا يملك التاريخ إلا أن يستحي أمام حزن الأمهات وهن يفقدن رجالهن وبيوتهن وكرامتهن وأمنهن أمام أطماع ساسة الجوار وأهواء حكامه. كنتُ خجلاً من ملايين الصور القديمة من حروب عاصرت فجر البشرية تمر بذاكرتي سراعاً، لطالما وضعت الأقدار آلاف المقاتلين وجهاً لوجه أمام حزن الأمهات. ولا أجد لغة أحاور بها هذا اليأس المريع المتمسّك بثوب الرضيع مثل شجرة في صحراء تقاوم بيأس هبوب رياح الخماسين. عمرها لا يزيد عن 20 عاماً وفي عينيها السوداوين النجلاوين وجعٌ يكفي شعوباً.
أرد مسدسي إلى غلافه خجلاً وأحاول أن أجد كلمة تقنعها بأن تتحدث إليّ، وكيف لامرأة فقدت تواً كل عالمها أن تحاور أحد الأعداء وهو يقف فوقها ببزته الرقطاء المرعبة وحذائه العسكري الغليظ الثقيل؟ رجلٌ إن لم تشأ أن تكرهه فإن ابنها النائم على صدرها سيجبرها أن تكرهه. يسيل على الأرض فجأة من تحت عباءتها الملتفّة حولها خيطٌ رفيع من سائل يتدفق سريعاً باتجاهي، فيتملكني حنق من نفسي مغمس بالمرارة، فأدور سريعأً وأخرج من باب السطح إلى داخل الطابق الثاني من البيت الأصفر، لا أريد أن أرى حياءها وخجلها يسيل أمامي لما حدث، أظل اتمشّى في الطابق الثاني ولا أدري من أين سأبدأ معها بعدما حدث.

عدت بعد نصف ساعة لأجدها قد غيرت مكان جلوسها وغيّرت ملابسها التي ابتلت بآثار الرعب البشري، تنظر إليّ بكل خوف الأمهات وهن ينهرن أمام كرامةٍ سالت فزعاً فوق سطح اسمنتي ساخن بحضور غريبٍ متجبّرٍ من الغزاة القتلة.
يحل الظلام وأنا سؤال هائم من ألم يتردد بين اللعن وبين الشوق لأن أفعل شيئاً يرمم حطام هذين الإنسانين المحشورين في مأزق مرعب قد لا يخرجان منه.
أسمع صوت سيارة تقف أمام الدار، أتطلع من فوق جدار السطح فلا أميّز سوى أنّها مركبة عسكرية، أنزل مسرعاً لأجد سائقها والجندي المخابر يبحثان عني، أقول لهما إنّ امرأة وطفلها بقيا محاصرين فوق سطح الدار ولابد من إخلائهما إلى مكان آمنٍ مع إحدى العائلات، فيجيبني السائق إنّه قد شاهد جمعاً كبيراً من العائلات المدنية أمام وزارة الزراعة بانتظار الحافلات التي ستأخذهم إلى العراق ومنه إلى الأردن. أعود لسطح المنزل فتواجهني الوردتان الخابيتان في زاويته، أحدّث الجدران بصوت عالٍ علّ امرأة فاجأها عسكري من الغزاة تنسى خوفها وتستجيب لصوت العقل. سيدتي أنهضي لأذهب بكِ بعيداً عن وطنك الذي بات ساحة حرب، لا يمكن أن تظلّي هنا لوحدكِ مع الغزاة والعسكر واللصوص، لا يمكن أن تبقي تحت سماء الرصاص واللهب، لا يمكن أن تظلي أمّاً بلا حدود، عجّلي لأذهب بكِ إلى مكان لا حربَ فيها.
حين وصلنا بالسيارة إلى مبنى وزارة الزراعة، كانت يد الرضيع تربّت على يدي وفي وجه أمّه بضعُ ابتسامة لا تجرؤ أن تلقيها في وجه عسكري غريب لا تريد أن ترنو إليه.
أساعدهما في الترجل من سيارة الواز، وأضعهما في إحدى الحافلات، ومن نافذتها ترنو إليّ عينا أمّ يلفها الحياء والامتنان، وتتسعان في وجهها لتقولا بصمتٍ “وداعاً أيها العدو الصديق”!
حزيران- 2002
*هذه حكاية رواها ضابط عراقي كان في الكويت، وشاركني بعد سنوات أياماً طويلة في زنزانة طولها 140 سنتمتر وعرضها متر واحد بسجن اسمه (ويا للمفارقة) طريق القدس، ولم يكن عندنا غير سرد الذكريات العتيقة لننسى رعب الانفرادي، وقد نقلتها هنا بسردٍ مفصّلٍ وأضفت لها أحاسيس اللحظة من عندي.
ملهم الملائكة/ من مجموعة خرائط العراقيين الغريبة






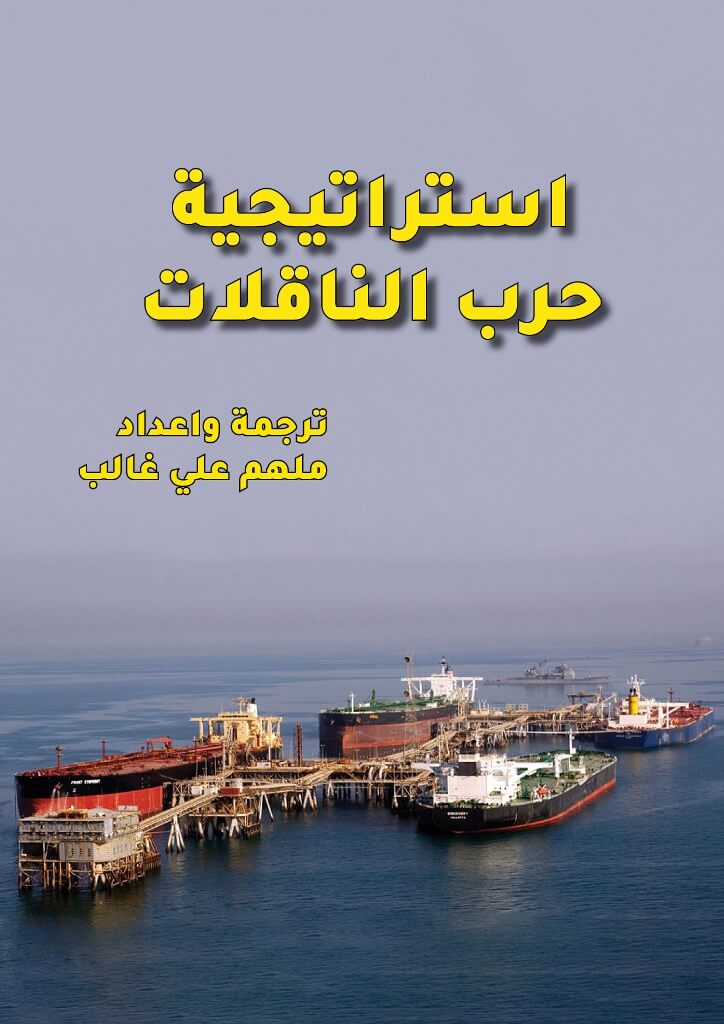
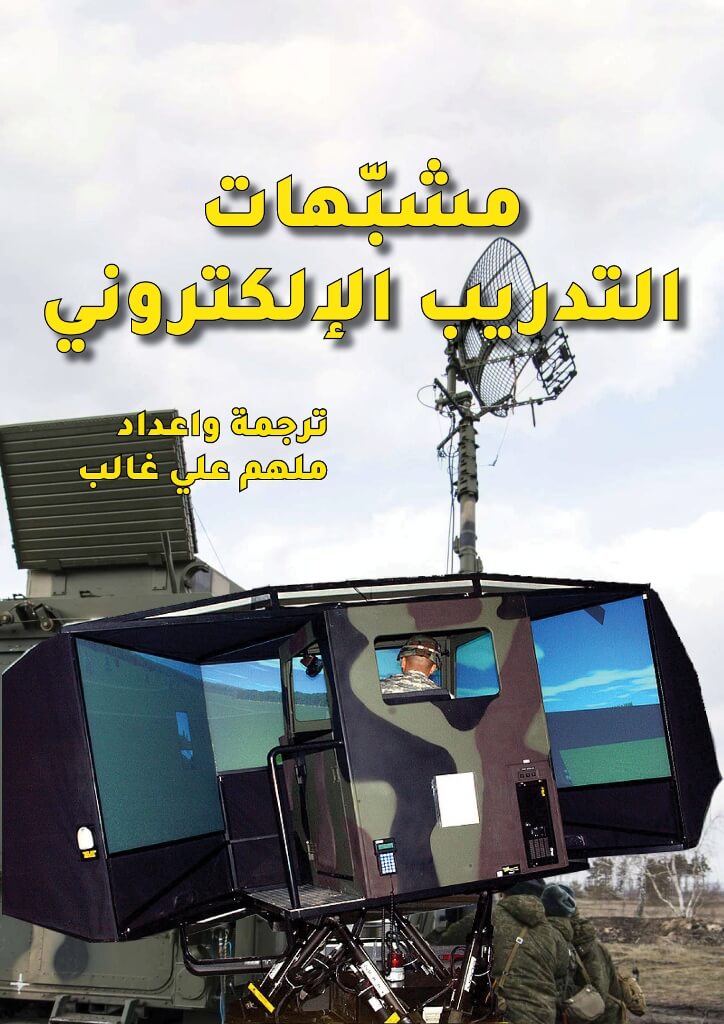
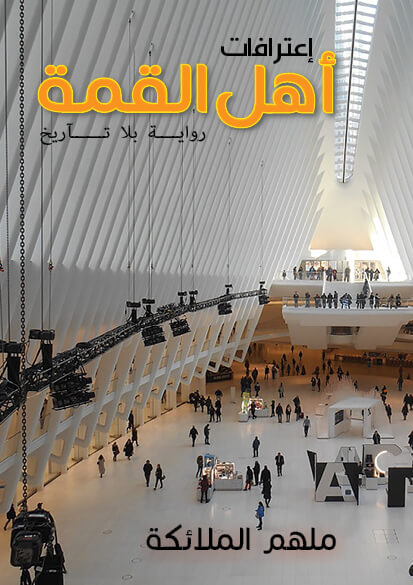




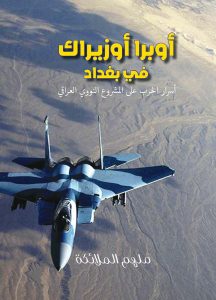
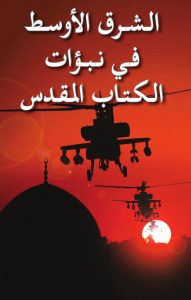








0 تعليق