عرفته على نزال في تنس الطاولة بإعدادية الجمهورية في بغداد، كان في الصف الخامس علمي، وأنا في الصف الرابع العام، ثم اكتشفنا أننا نسكن في نفس المنطقة في زمن كانت تتشكل فيه الطبقة الوسطى في العراق وتمد جذورها في عمق تراب البلد أملاً في أن تصبح صانعة شخصية الوطن، كما هو حال الأمم. لم يكن في شكل الفتى الكردي المشغول بالسياسة لحد الثمالة شيئاً مميزاً، لكنّ كلّ أبناء المحلة الجديدة كانوا يلمسون فيه تفرّداً في الشخصية لم يستطيعوا أن يحددوا أسبابه، أما بالنسبة لي، كانت عبارته الرشيقة المقتطعة من ماوتسي تونغ “مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة” جملة خالدة، لفتت انتباهي إلى عمق مستوى تفكيره ونوع قراءاته منذ لقائي الأول به.
جمعتنا منطقة موظفين في أطراف شرق العاصمة، ولبغداد آنذاك طرفان سكنهما موظفو الحكومة، الشرقي وهو يقع عموماً شرق دجلة، شرق قناة الجيش في بغداد، والغربي، وهو يقع جنوب مرسلات أبو غريب، ويتصل حتى كلية الزراعة والطب البيطري، ويضم الداوودي والخضراء والغزالية والأحياء المتفرعة عنه. أما وسط العاصمة فكان من نصيب ضباط الجيش، فمنحوا أراضٍ في الربيعي وزيونه والمأمون واليرموك والكاظمية، فيما نال ضباط الشرطة أراضٍ في حي الشرطة قرب حي العدل وحي الجامعة وصولاً الى بعض مناطق المنصور. تلكم أراضٍ وزعها الزعيم على موظفي الدولة بسعر درهم واحد للمتر المربع، وكلها قطع 600 متر. كانت تلك محاولة عملية لصناعة طبقة وسطى قوية في العراق، ونجحت المحاولة، وهكذا توزعت منطقة البلديات على موظفي الدولة، فصارت مناطقها تعرف بالاقتصاد، المالية، النفوس، الصحة، الزراعة، الآثار، الاعلام، الفنانين، العقاري، التربية وضباط ومراتب شرطة الكمارك. وقد بنى أمي وأبي بيتاً فيها بعد أن رفضت والدتي قطعة أرض وزعتها الدولة للمعلمين والمدرسين في شرق القناة جهة بغداد الجديدة، وبعد أن رفض أبي قطعة أرض أخرى حصل عليها من جمعية الفنانين العراقيين في حي الفنانين في البلديات نفسها.
ولم يكن غريباً أن نلتقي نحن الشباب، ولم يكن أمامنا سوى خيار اللقاء والتمشي العبثي، فلا شيء في المنطقة سوى بيوت وشارع نصف معبد، وحافلة نقل ركاب تزورنا مرة كل ساعة، وهكذا كان على الشباب أن يصنعوا ويعيشوا عالمهم. وصنعنا مجتمعاً صغيراً وعشنا عالمنا، وأغرب شيء أننا كنّا بين السادسة عشرة والثامنة عشرة، ومع ذلك لم يعشق فينا أحد الرياضة. تجاوز عدد أفراد مجموعتنا 10 شبان، وبدأ يلتحق بنا آخرون من مناطق أبعد، لكنها جميعا تدور في محيط البلديات. المنطقة مساحات شاسعة من أراضٍ خالية غير مبنية، تتخللها تجمعات سكانية في بيوت وتتوسطها بضعة مدارس ومحاولة سوق اسمه السوق الشعبي. ومن غرائب صديقي الجديد كاميران أنه كان يرتدي بدلات أنيقة خيطت من قماش ثمين، بصفين من الأزرار وياقة عريضة كما هو موديل تلك الفترة، وينتعل تحتها نعل بلاستيك أو اسفنج أو جلد؟ والحقيقة أن منظره كان غريباً وهو يتخطى فوق شارع البلديات الرئيسي مرتديا بذلته النيلية الأنيقة، وتحتها نعل حمام اسفنجي! وما كنت أفهم من ألهمه تلك التشكيلة الغريبة، لكني في قرارة نفسي كنت استاء منها وتثير قرفي.
واكتشفنا بعد أن مضى العام الدراسي قدماً، أنّ نصف البلديات الجنوبي الأقرب إلى زيونة والمشتل، فيه مقهى، يضم فريقين لكرة القدم، علاوة على نواة بعثية، ستصبح بعد أسابيع الفرقة الحزبية، وتستقر في بناية مدرسة ابتدائية للبنات. نحن نتحدث عن عام 1970 وعام 1971، وكان عمر دولة البعث سنتان فحسب! أحباب الرياضة كانوا غالباً أحباب البعث، وباتوا مقربين للبعثيين وصاروا هم البعثيين الجدد. وفي نفوس الناس، كانت جروح البعث ما زالت ندية، وما نسي العراقيون فظائع الحرس القومي وفضائحهم في عام 1963، لكن حكومة الجنرال أحمد حسن البكر كانت تسعى أن تمحو ذلك التاريخ بمنجزات سريعة على الطريقة الكوبية.
في مجموعتنا الفتية، كان بضعة أكراد، بمستويات وعي متباينة، فبعضهم متعصب قومياً لدرجة انه لا يرى مصالح الكرد في البلد، أما صديقنا كاميران (اسم مستعار) فكان أكثرنا تحسساً للوضع السياسي في البلد، او هكذا كنت اتخيله، وكان يحاول أن يوجه اهتمامنا إلى أنّ في العالم أشياء أخرى مهمة كأهمية البنات! الفتى كان يتعلم من أبيه وشقيقه الأكبر وهما من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرع الخامس، وحين كنّا نقارن وعينا بوعيه في مجال السياسة، كنا نجد أنفسنا مجرد أطفال نحاول أن نتعلم تهجّي حروف هذا العلم الغامض. من جانبي كنت أحاول فهم السياسة، لكني ما كنت قادراً على مغادرة المظلة الماركسية التي تخيم على بيتنا، وكانت تلك المظلة تصل بي دائماً إلى نفس النتائج، وتقدم لي عين الحلول لأزمات البلد المتعاقبة. وتفوّق كاميران علينا في مضمار النساء، فكان دون جوان لا مثيل له، يحقق انتصارات تثير فينا الحسرة والحسد. والغريب أنّ البنات وحتى النساء الأكبر سنّا كنّ أيضا معجبات به، ويستجبن لمقارباته الغزلية. ثم اكتشفت أنّ لديه حبيبة من أقاربه، يكتب رمز اسمها على كتبه ودفاتره. وحكى لي أنها الحبيبة الحقيقية التي تنتهي عندها كل مغامراته، فهي التي يعشقها ويروم الزواج بها، وهكذا تعلمت أن أضع رمزاً لاسم حبيبتي على كتبي ودفاتري، إذ كنت أنا الآخر امتلك حبيبة من أقاربي، وأعشقها وأحلم بالزواج بها، وهكذا باتت العلاقة الجادة بالمؤنث قاسماً مشتركاً بيننا، وسعينا أن نخرج نحن الأربعة في جولة عاشقين في حديقة الزوراء ببغداد أو إلى إحدى صالات العرض السينمائية فيها مطلع سبعينات القرن العشرين، لكنّ الفرصة لم تسنح لنا قط.
صداقتي بكاميران مرت دائماً بمحطات السفر، وطالما استوقفني هذا الأمر فيما بعد وأنا اتأمل تلك اللقاءات، فقد كانت تمر محملة بالحقائب متسارعة لتفرّقنا سراعاً كقطارات تغادر محطات انقضت أعمارها، ولم تعد سككها تتصل بسككنا. وحين حلّ نوروز في 21 آذار 1972، سافرت معه بدعوة منه دون حقائب إلى غابات القصيبة في الزعفرانية جنوب بغداد، وهي ضفة من ضفاف دجلة، تكللها أكمة من القصب، وتمتد حولها مساحات خضراء بلا زرع، الحزب الديمقراطي الكردستاني أحيى احتفالاً بعيد نوروز بتلك المنطقة، ثم أوقدوا نيراناً، وحول النيران تحلق الشباب والشابات يدبكون ويغنون ويرقصون، واختلط بالجمع عدد كبير من الشبيبة العرب والعرب العراقيين، أغلبهم من الشيوعيين. تلك مرحلة لم يفرض خلالها بعد حزب البعث ديكتاتوريته المطلقة على العراق، فهو مشغول بالمؤامرات الداخلية والخارجية، والصراع بين القيادات. كان يوماً رائعاً، وربيعاً مشرقاً، وأشاع المهرجان في النفوس فرح وبهجة صنعها التقارب بين الملل والثقافات والفنون.
ثم قررنا في صيف نفس العام أن نذهب في رحلة إلى الموصل ودهوك منها إلى سرسنك، ثم إلى سلسلة القرى الكردية المنسية على سفوح جبال تربط العراق بتركيا، ومنها نعود إلى أربيل، ومنها نكرّ إلى العاصمة. كانت رحلة طموحة بدت لي للوهلة الأولى مشروعاً سياحيا رائعاً. وأخذنا القطار الذاهب الى الموصل أنا وهو واثنان من أقاربه. رحلة القطار كانت كارثية منذ انطلاقها، فقد أصاب الماكنة عطل في المشاهدة على مشارف بغداد، بعد ساعة من مغادرتنا المحطة العالمية العتيدة، ثم أرسلوا لنا قاطرة تدفعنا شمالاً (بدلاً أن تسحبنا كما هو حال الديزلات في العادة)، وبقي الحال هكذا، وبعد كل مسيرة لبضع ساعات، تعطل الماكنة، وننتظر أخرى تأتي لتسحبنا أو لتدفعنا! حتى توقفنا في محطة خارج بيجي، وكان وقوفاً مطوّلاً وسط الصحراء لساعات طويلة ولا سبيل للحركة، بقينا تائهين في العراء بلا زاد ولا مأوى، حتى جاءتنا من الموصل نفسها قاطرة تسحبنا. مجمل الرحلة من بغداد إلى الموصل استغرقت 11 ساعة. ومنذ البداية طغى على برنامجنا خلل فاضح لا سبيل لإصلاحه، فرفاق السفر، يتكلمون الكردية كل الوقت، متناسين وجودي معهم، وهكذا تقضّت أيامنا في ملل وقرف بلا نهاية، وتبين أنّ الرحلة البائسة لم تكن أكثر من برنامج يزورون خلاله أقاربهم، والأسوأ من هذا أنّ الزيارة كانت مفعمة بالمرارة، وزيارتنا للبيوت المنتشرة في المدن والقرى بقيت مجرد رحلات عتب وكلمات غاضبة، وجلسات مطولة يتخللها حديث لا ينتهي بالكردية بين رجال ونساء لا أفقه منهم شيء. وقضيت أسوأ عشرة أيام في حياتي، وصرت أفكر أن اكتب عنها قصة بعنوان “عشرة أيام من القرف التاريخي”، لكنّي لم أنفذ تلك الفكرة لأنّ الملل لا يكتب موضوعاً مثيراً وجذّاباً للقراءة. على كل حال، ربما أتيح لي في زمن ما أن أكتب قصة تلك الأيام العشرة، على طريقة كتاب الأمريكي اليساري الاشتراكي جون ريد “عشرة أيام هزت العالم”! وهو، بالمناسبة، كتابٌ دأب كاميران على الإشارة إليه باعتباره توثيقاً هاماً للتجربة الشيوعية في روسيا. ولم ألق باللوم على صديقي، بل التمست له العذر معتبراً أنّ ظروف القبيلة وخصوصيات الانتماء السياسي الكردي هي المسؤولة عن مواقفه الموغلة في الإهمال!
ثم صرنا نسمع عن استعدادات العراق للمشاركة في مهرجان الشبيبة العالمي العاشر في برلين عاصمة ألمانيا الديمقراطية في صيف عام 1973، وفجأة علمنا أنّ كاميران وشقيقه مشاركين في المهرجان كممثلين عن اتحاد الشبيبة الكردستاني الذي بات علنياً وله مقرات في بغداد ومدن العراق، ومن مقراته التي زرتها، مقر الفرع الخامس قرب فندق امباسدور بشارع ابي نؤاس. وانهمك صديقنا في الاستعدادات واستخرج جواز سفر، وابتاع ملابس حسب أنها مناسبة للسفر، ومن بينها بدلتان، احداهما زرقاء والأخرى رمادية، أثارتا أعجابي المقرون بعجبي ودهشتي، وقلت له معترضاً إنّ الشباب لا يرتدون في لقاءاتهم الدولية بدلات، بل ملابس عفوية، سراويل جينز، قمصان، بلوزات، قماصل جلدية وما شابه، لكنه أصرّ على أهميتها باعتباره عضواً في وفد رسمي ولا بد له من مظهر رسمي جاد، وأثار هذا حيرتي، فكيف تكون فعاليات الشباب رسمية؟! هل سيلتقي بهذه البدلات بانجيلا ديفز وبوب ديلان وجون بايز وماكس ثيوردور آكس وإيرين باباس وباقي نجوم اليسار الشباب؟ وخمّنت أنهما انتخبا هذا المظهر بوحي البيروقراطية الناشئة التي كانت تدب بين العراقيين بسبب التوسع في منح الوظائف الحكومية، والتنمية الاقتصادية المقرونة بالتوجيه السياسي لأحزاب العراق الكبرى، البعث، والشيوعي، والكردستاني.
وسافر كاميران إلى برلين، وعاد بعد نحو أسبوع محملاً بالقصص والانطباعات، لكنه لم يغفل أن ينقل لنا انطباعاته عن تخلّف الدولة الشيوعية المضيفة للمهرجان، وذهلنا لوصفه لجوانب الفشل في تجربة ألمانيا الديمقراطية، ومن الغريب حقاً أن يلحظ أخطاء التجربة وهو في ذلك العمر الفتي المبكر. وعاد لنا أيضاً بكنز من الصور والسلايدات، لا سيما أنه وشقيقه قد ابتاعا كاميرات براكتكا واكزاكتا وكاميرا تصوير سينمائي وعارضة 8 ملم خصيصاً لتلك الرحلة! ومن ملامح الحداثة المبكرة التي لمستها في تلك المرحلة، هي أن كاميران وشقيقه قد رتبا في بيتهما معرضاً ضم صور وفعاليات المهرجان وعدداً كبيراً من بوستراته، وكان ذلك كنز معلومات لا ينضب.
ذلك العام أنهى صديقي الإعدادية، وكانت عقبة البكالوريا مدمرة، فتخرج بمعدل ضعيف، أهّله للقبول في الدورة الأولى بمعهد الفندقة والسياحة في الجامعة المستنصرية، وصرنا نتندر عليه باعتبار أنه سيحمل شهادة “بوي جامعي”، وغرق هو في يأسه وخيبته وهو يرى مستقبل الشهادة البائسة، ويحتار كيف يتصرف. وقبل أن ينتهي العام، حصل على قبول في كلية الطب بجامعة بوخارست برومانيا، ورحل فجأة بحقائب أعدت على عجل. ومن أين كنّا سنعرف أنّ ذاك الفراق سيكون طويلاً، وأبدياً بالنسبة لكثيرين. وتفجّر القتال في شمال العراق مرة أخرى، وتحرك الملا مصطفى بارزاني متحدياً دولة البعث، فيما تمزقت الوحدة السياسية الكردية، وظهر زعيم كردي جديد اسمه جلال طالباني، وأسس حزباً كردياً بات يعرف بالاتحاد الوطني الكردستاني “يكيتيا”. واختفت عائلة كاميران من المنطقة فجأة، ولم يعرف أحد ما جرى لهم، ثم استولى دلال مجهول على بيتهم الكبير الأنيق، وبعد أشهر جعلوا البيت مدرسة هي ثانوية عائشة للبنات، ومن عجب أنّ رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة العراق في تلك الثانوية كانت ابنة ذلك الدلال “المجهول”!؟
أما أنا فقد نجحت في لقاء كاميران بأوروبا، بعد أن قبلت في كلية الآداب جامعة بغداد. ففي عام 1976 حصلت على سلفة طلابية قدرها (80 دينار) وعززها والدي ب (150 ديناراً)، فصار عندي رأسمال معتبر (نحو 700 دولار) يكفي لرحلة محترمة في أرجاء أوروبا الشرقية. وضمن محطات رحلتي التي استغرقت شهرين إلى تركيا وأربعة بلدان من أوروبا الشرقية التقيته في حرم جامعة بوخارست بجمهورية رومانيا في أوج عصر شاوشيسكو، وزرته فوجدته مع صديقته الرومانية في غرفتهما بالقسم الداخلي. انطباعي عنه أن حياته إبان تلك الزيارة كانت موزعة بين لعب الورق لأيام وليال لا نهاية لها، وبين الحياة مع صديقته الرومانية، أما الدراسة الطبية فكانت آخر ما يفكر به! بوخارست التي كانت قد ضربها توّاً زلزال مدمر بدت كئيبة عابسة…وبالإمكان القول إنها مدينة بلا فرح ولا بهجة، فآثار الزلزال تظهر شقوقاً في جدران المباني وحتى الجسور، والمواصلات رديئة وغير منتظمة، والشباب الروماني يتطلع بلهفة الى جموع الشبيبة القادمين من البلدان العربية ليتعرفوا على التجربة الاشتراكية على حقيقتها، وكان غريباً جداً تفوقهم على شبيبة أوروبا الشرقية بقدراتهم المالية الفقيرة رغم أنهم كانوا مجرد طلبة. الملفت للنظر بين السائحين العراقيين، هو جموع السائقين والفيترية والحدادين والنجارين، الذين عرفوا طريق السفر الى أوروبا الشيوعية بقدراتهم المالية المتفوقة آنذاك. وكان منظرهم وهم سكارى في الأقسام الداخلية لجامعة بوخارست يعتنقون الشقراوات الشيوعيات يثير الأسى ويحرك في النفس أسئلة حول مستوى فقر المجتمعات في بلدان حلف وارشو…وتولّد في نفسي انطباعٌ بأن الاشتراكية هي اشتراكية الفقر بين الناس، وهو فقر لا يطال الطبقة الحاكمة حزبياً ووظيفياً، ولعل هذا نفسه سيكون وضع التجربة الاشتراكية البعثية في العراق بعد سنوات! وحين كشفت مشاعري وانطباعاتي لصديقي كاميران أجابني بضحكة غامضة، فهو لم يكن يملك إجابات.
في تلك الرحلة تعرفت على ابن أحد شيوخ قبائل السودان واسمه أمير، وهو شاب وسيم مثقف، يبدو أن التجربة الاشتراكية في بلدان أوروبا الشرقية قد صدمته فبات يحذر من اعلان نفسه شيوعياً أو حتى يسارياً تحسباً من تداعيات غير محسوبة قد ينتجها الانتماء للمعسكر الأحمر. وانتهت زيارتي لرومانيا، فودعت أمير على أمل لقاء يترسّم له أن يتم في أحد بلدان أمريكا اللاتينية، بعيداً عن كل أوروبا الشيوعية التي عاش فيها، وحين ودعت كاميران وأنا أسافر بالقطار إلى محطتي القادمة في هنغاريا، كان شعورنا معاً أن لقاء آخر بيننا غير مرجح…ربما إلى أبد.
وتقلّب العراق من حكومة إلى حكومة، ومن حرب إلى حرب، وتوالت علينا المصائب والهجرات، وتبدّلت أحوالنا، وتبدّلت حبيباتنا، وتبدّلت بيوتنا، وبقينا متباعدين حتى التقينا في ألمانيا عام 2005، وما إن عرف صديقي العتيق أني اشتغل في مؤسسة دي دبليو للإعلام الألماني، حتى سافر إليّ قاطعاً بسيارته مسافة 350 كيلومترا من سويسرا التي يقيم فيها ليلتقيني بعد كل تلكم السنون. وعادت صداقتنا بقوة في لقاء حافل بالذكريات والمشاعر بكافتريا مؤسسة دي دبليو بمدينة بون غرب ألمانيا، وما لبثنا أن التقينا مرة أخرى عام 2006، كالعادة في محطة سفر، وكان ذلك في مطار أربيل ونحن نحمل حقائب سفرنا المفترق، وانقذتني حصانته البرلمانية من مشكلة حاول ضابط جوازات المطار أن يثيرها بشأن فيزا زوجتي لدخول ألمانيا، وتمكن كاميران عبر اتصال على أعلى مستويات القيادة الكردية أن يمنع الكارثة التي سعى أن يلحقها بنا الضابط الكردي. حينها كنت أعمل في الاعلام الأوروبي، وصديقي كان نائباً في البرلمان العراقي الجديد. كبر ابناؤنا في أوروبا وتقاعدنا لتبقى صداقتنا تروي قصة 51 عاماً من لقاءات متباعدة مثل قطرات عطر في قارورة رياح.
بون – خريف 2022






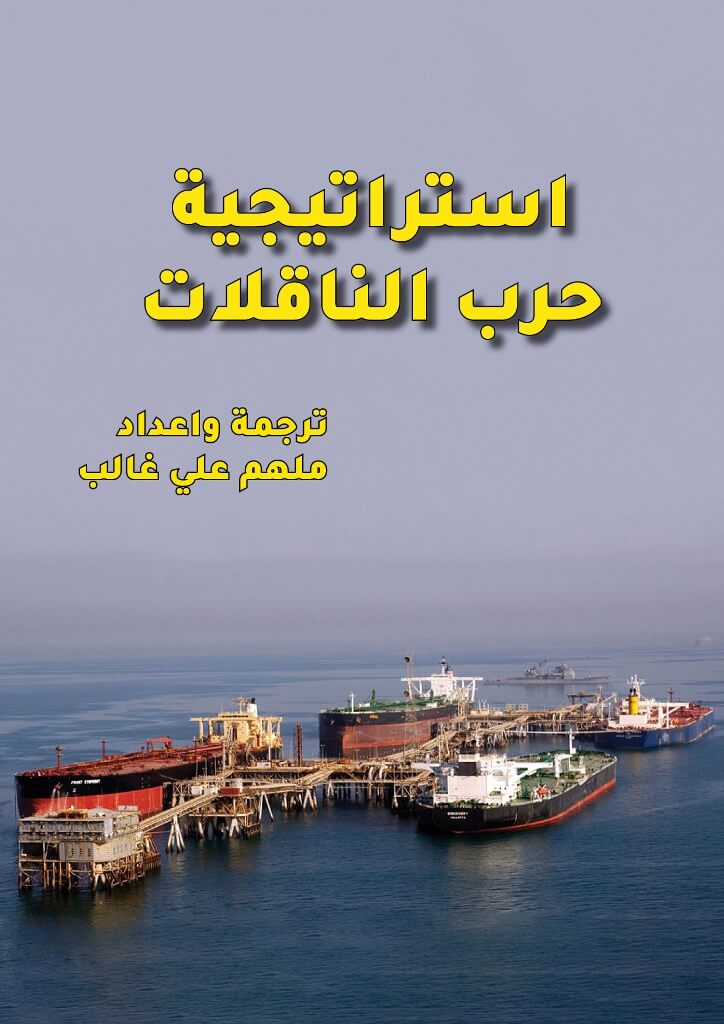
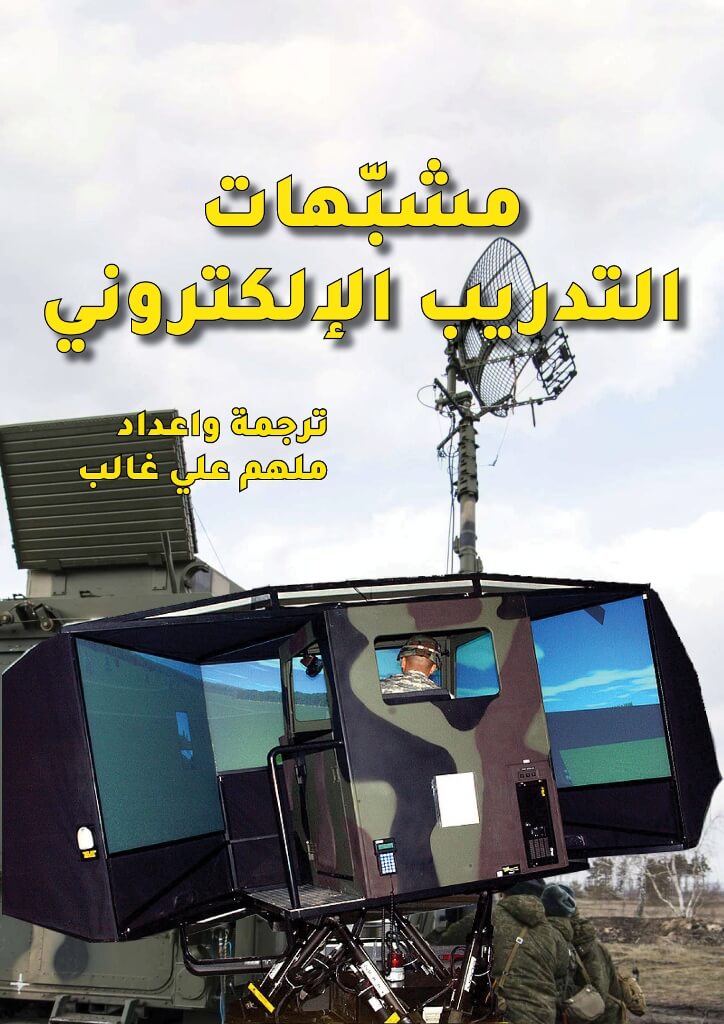
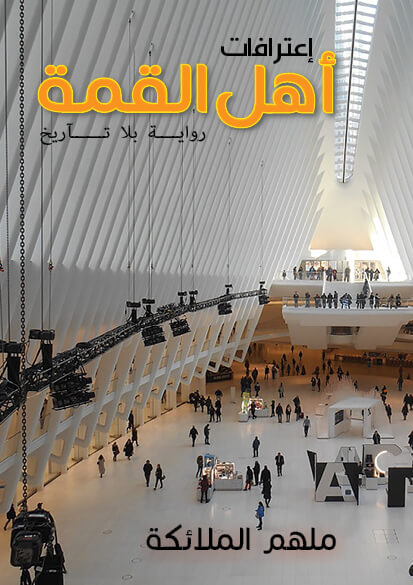




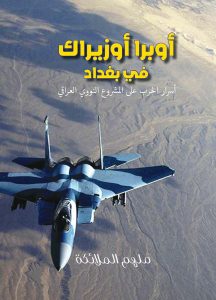
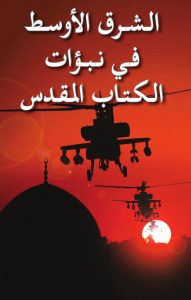








0 تعليق